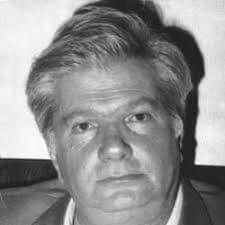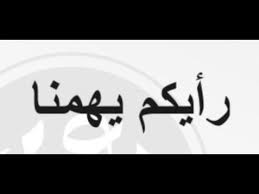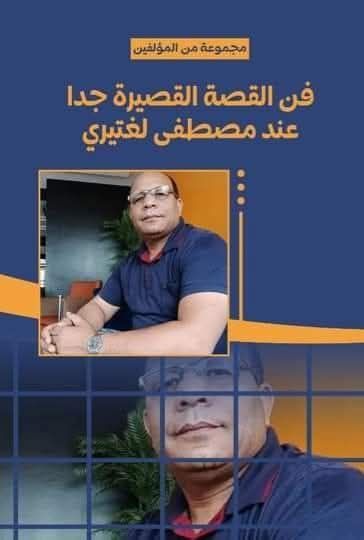حوار مع غالب هلسا:
لا تقرأوا نجيب محفوظ
لغالب هلسا طعم ونكهة يعرفها من يتابع أدبه الإبداعي، بدأت بواكيرها يوم بدأ بواكير نتاجه، وقد شمل
المسرح:
عودة الشباب
القصة القصيرة:
وديع والقديسة ميلادة وآخرون /1968، زنوج وبدو وفلاحون /1976/
الروايات:
الضحك/ 1970/
الخماسين/1973/
السؤال /1979/
البكاء على الأطلال /1981/
ثلاثة وجوه لبغداد /1985/
سلطانة /1988/
الروائيون /1989/
في كل هذا النتاج الإبداعي، وحتى دراساته النقدية:
قراءات نقدية /1979/
فصول في النقد /1986/
الفلسفة الإسلامية
العالم مادة وحركة /1981/
الجهل في معركة الحضارة /1982/
في كل هذا الفيض الإبداعي يلمس القارئ نكهة خاصة، فهنا الحس التسجيلي الذي يلتقط نبض الواقع المحيط بتفاصيل تجعل الصورة واضحة وراسخة، إضافة إلى الرؤية الذاتية وتفاصيل السيرة المبثوثة هنا وهناك. وإذا كانت هذه من بعض أصالة الكاتب، فإن لدى غالب هلسا مفهوماً للأصالة أعمق وأكبر في الأثر.
إنه في أصالته لا ينطلق على سجيته مطبوعة بعفوية الإبداع فحسب، ولكنه يستند لذخيرة واسعة من القراءات التي شملت معظم إنتاج الفكر الإنساني، وله من ترجماته المتميزة خير برهان على سعة الإطلاع ونوعية هذا الإطلاع. ومن ترجماته المعروفة: جماليات المكان لغاستون باشلار، الحارس في حقل الشوفان /سالنجر/ وثمة كتاب عن فوكنر وآخر عن برنارد شو.
وفي أزقة دمشق وحواريها، أخريات العام /1987/ بدأت فكرة هذا اللقاء، والذي قدر له أن ينتظر طويلاً حتى كانت فرصة نشره ـ هذه.. ـ بعد أربع سنين من رحيل أديب كبير التجربة، كبير العطاء.. سيظل أدبه حياً لأجيال وأجيال..
ولعل في هذا الحوار بعض محاولة للدخول إلى عالم غالب هلسا، وهو عالم مركب.. وقد زادته التجارب عمقاً ودلالة..
بودي أن ندخل في التكنيك الروائي مباشرة. كيف تفهم الرواية، ومتى تباشر كتابتها فعلاً؟
▪︎هي فكرة تطرأ في الذهن، أو صورة، أو إحساس ما، وفي الغالب أتصور أن الشكل الذي تصلح له هذه كلها هو القصة القصيرة، فمعظم رواياتي بدأتها باعتبارها قصة قصيرة. وأحياناً يكون إحساساً عاماً، وأعلم أنني سأكتب رواية، ففي رواية السؤال كان إحساسي الأساسي هو الإلفة التي يمنحها البيت أمام عالم خارجي معادٍ ومتربص، كان ذلك يشبه أن تكون في مكان دافئ، وفي الخارج يتساقط الثلج والبرد هكذا كان إحساسي الأساسي في هذه الرواية، ثم اكتشفت أنه شق طريقه إلى موضوعات أخرى..
هذا يحدث معي دائماً. أذكر في بداية كتابة رواية الضحك أنني كنت أسير مع صديق أمريكي زنجي في شارع سليمان بالقاهرة فجاءني إحساس غريب أن كل شيء يبدو مضحكاً.. العشاق السائرون في الشارع يعبرون عن ميلودرامية مضى عهدها، وسائقو السيارات وهم متجهمون وجادون، غرسونات مطعم روسي والأميركيون وهم متجهون وعابسون.. يركضون بسرعة لتلبية طلبات الزبائن. كان الإحساس بالضحك يتسرب من كل شيء حولي فقلت لصديقي الأمريكي: “آي فيل فاني”، وشرحت له ما أشعر به، فقال هذه تصلح موضوعاً لقصة. وبالفعل عدت إلى البيت.
وفي ذهني كتابة قصة قصيرة، ولكن الرواية امتدت حتى أصبحت خمسمائة صفحة. حدث نفس الشيء بالنسبة لرواية البكاء على الأطلال، حيث كنت أزور صديقاً وقامت زوجته الطفلة لي ولكن الطفلة أرهقتني.. فخطرت في ذهني قصة قصيرة عن أكذوبة براءة الطفولة، ثم تحولت إلى رواية.
في أحيان أخرى تسيطر على شخصيات.. أذكر أنني تعرفت على صديقة في مصر، وعرفتني إلى أبيها وأمها، فضغط على هذان النمطان فكتبت بعد ذلك مسرحية التلفون. وهذا يجعلني أقول إن العمل الأدبي لا يكتب بدافع واحد أو سبب واحد، ولكني حين أكتب لا أستطيع السيطرة على موضوعي.. وحتى إذا وضعت تخطيطاً فإن الشخصيات والأحداث تأخذ استقلالها. أكتب، مثلاً، في اليوم ساعتين، ثم أنسى كل شيء عن الرواية، وفي اليوم التالي.. في نفس الموعد.. أمسك القلم والورقة وذهني خالٍ تماماً، ولكن بمجرد أن أمسك القلم أجد أن الكتابة جاهزة، وتتوقف الكتابة من ذاتها، أصل للحظة لا أستطيع الاستمرار.
على كل حال، الآن صدرت رواية “الروائيون”، وهي تحكي تجربة كتابة الرواية كواحد من موضوعاتها..
▪︎مع أنك لم تجبني عن سؤالي مباشرة فإني أشعر أنني أستطيع الوقوف على الجواب من خلال سردك لبدايات عدد من أعمالك. وبالرجوع إلى ما تقدم يتهيأ لي أن الرواية عندك فضاء رحب يتسع لأكثر من موضوع وأكثر من رأي، تبدأ روايتك بشرارة ما أو ومضة ما، ثم تأخذ انفلاتها واتساعها.. دون قيود. مع ذلك أشعر أن لكل رواية عندك مركز ثقل خاص، فرواية مثل (السؤال) هي سؤال يتكرر بصور مختلفة يمكن اختصاره إلى.. علاقة الأنا بالآخر، ومتى وكيف يحب أن تكون. سلطانة هي مصادرة هذه (الأنا) وكيفية استردادها..؟. هل هذا ما يمكن الحديث فيه؟
رواياتي لا تنطلق من فكرة، ولا تعبر عن فكرة. حتى موضوع الرواية يكون مطروحاً في ذهني، ولكن الرواية تأخذ اتجاهاً آخر.
القضايا المطروحة في ذهني أساساً، التي تتسلل إلى الرواية، هي علاقة المثقف بالعالم، أي بالحزب السياسي، السلطة، وأكثر من هذا كله.. علاقته بالشعب. وهي قضايا ليست ذهنية في ذهني فقط، ولكنها قضايا حياة. لا يمن أن تتصور مدى الجهد الذي أبذله لأعرف الحي الشعبي، سواء في مصر أو في العراق أو في سورية. أحياناً أشعر بالاختناق عندما أجلس في مقهى في حي شعبي، وأشعر أن العالم من حولي ليس جزءاً من معرفة كاملة، وبالطبع اكتشف فيما بعد أنني عرفت عن هذا الحي الشعبي أكثر مما كنت أتصور،لماذا الحي الشعبي بالذات؟
▪︎لأنه تبين لي أنه في الحي الشعبي كل الناس يعرفون بعضهم، ويعرفون كل شيء عن بعضهم. إذن فهناك خصوبة حياة ومعرفة لا تتوافر في جو المثقفين…
الشيء الآخر اكتشافي في الحي الشعبي المصري لنمط جديد من المرأة، المرأة الحرة إلى أقصى حد، والتي تملك روحاً إنسانية نادرة. لم أجد في حياتي نساء كهؤلاء النساء يملكن القوة ويملكن الإحساس العميق بأن ألم الرجل، ورغبة الرجل، مقدسان. وعندما تشعر المرأة هذا الشعور تصبح عطاء ثرياً لا حدود له، وتصبح خصوبة لا نهائية.. هذا الثراء كان يثير عندي الإحساس بالهدر، أن طاقات عظيمة ورائعة سوف تنتهي وتموت.. دون أن نعرف عنها شيئاً.
علاقة الحزب السياسي، وهي علاقة إشكالية، لأنني لم أستطع أن أحسم مسألة ذوبان الفرد المطلق في قضية. إحساسي العميق أن العلاقة بقضية يعني جدلاً معها، ولكن الحزب السياسي ـ كما عرفته ـ يبحث عن إيمانية مطلقة فالإشكالية هنا.. هل أكون أداة لقضية لا أستطيع أن أعبر عن نفسي كفرد من خلالها.
أم أقف وحيداً تماماً، وأقول وحيداً تماماً لأنني لم أعش في داخل عائلة، وليس لي عائلة حالياً، وعلاقاتي مع العالم ـ إلا في القليل النادر ـ لها طابع عملي.
هنالك قضايا أخرى.. مثل الوجود في العالم، أو رعب الوجود، الذي ألجأني منذ سنتين إلى طب الأعصاب. هذه قضايا تتسلل إلى كتابتي دون أن تكون هي موضوعها.
السؤال الذي لا أجد له إجابة عندما يسألني ناقد أو صديق قائلاً.. ماذا أردت أن تقول في هذه الرواية، فأقول:
▪︎”هل يمكن الإجابة عن سؤال كهذا.؟!”.
إنني بالفعل لا أود أن أقول شيئاً محدداً، بل ليس من واجبي، ولا في قدرتي، أن أجيب. ربما كان هذا هو السبب الذي جعلني لا أنشر أعمالي إلا بعد كتابتها بمدة طويلة.. “وديع والقديسة ميلادة.. وآخرون” نشرت بعد كتابتها باثني عشر عاماً، أما “زنوج وبدو وفلاحون” فقد نشرت بعد كتابتها بعشرين سنة وكنت أعتقد أن على الكاتب أن يقول شيئاً محدداً، ولكنني كنت باستمرار عاجزاً عن تبين ما أريد قوله في الرواية..
إذا كان الروائيون يريدون أن يقولوا شيئاً محدداً فلست واحداً منهم، لذلك يفاجئني باستمرار، ردود فعل من النقاد والقراء غير متوقعة. ورغم أنها في السطح تبدو كردود فعل أخلاقية، أي كاعتراض على المواصفات الاجتماعية، وعلى التقاليد، ولكنني أشعر أن وراءها هذا الإلحاح على أن تكون الرواية شفافة ليتم اكتشاف الأفكار التي وراءها.
وإذا انتقلنا إلى رأيي كناقد فأنا أعتقد أن الرواية الحقيقية هي تلك المكتوبة عن تجربة ولا تنطلق من فكرة. وإن مشكلة الرواية العربية هي أنها شقت طريقاً خاصاً بها يتمثل بكونها تعبيراً عن فكرة، وقد رددت ذلك في بعض دراساتي إلى سيطرة المجتمع الأبوي في الحياة العربية، وإلى عدم تشكل الفرد بشكل ناضج ونهائي في مجتمعنا العربي.
▪︎ لأمر ما أجد أننا في طريقنا إلى وفاق مشروع، فأنت كروائي تعي جيداً أن للرواية حياتها الخاصة بها، وهذا ضروري من كل بد. ولكنك لا تنس ـ وأنت القارئ والناقد أيضاً ـ أننا مازلنا نبحث في الرواية عن شيء تعودنا أن نجده، شيء يمكن لنا أن نسميه مقولة الرواية أو الغاية منها..
سلطانة، مثلاً، هل هي مجرد امرأة، أم تحولات امرأة، أم حلم امرأة.؟..
أظنك سمعت جملة من الآراء تركزت كلها في أسئلة تدور في هذا الإطار.
إذن أنت كروائي مطالب، وهذا غير ما تنويه بشكل أو بآخر، بتقديم مقولة ما.ز إذ يبدو أن هذا هو القاسم المشترك الذي يريده. القارئ على الدوام. إلى أي حد ترى أن لهذا القارئ الحق في أن يبحث عن هذه المقولة، وهل تعتقد حقاً أن رواياتك لا تشف عن شيء من هذا، حتى لو لم تقصد أنت إليه..؟!.
▪︎ أعتقد أنه بالنسبة للفن، أي فن.. رواية أو موسيقا أو رسم أو نحت.. الخ، إننا نفقر هذا الفن إذا اعتبرناه مجرد طرح لفكرة. أعتقد أن الفن الحقيقي قادر على طرح أفكار وتجارب لا نهائية. لماذا أقول لا نهائية.؟! لأن ما يتم إقامته من علاقة بين العمل الأدبي وبين القارئ هو حوار بين تجربة القارئ وتجربة الكاتب. أي أن القارئ يشعر أن الكاتب قد عبر عن تجاربه الخاصة برؤية جديدة. هنا تصبح الرواية أداة معرفية، بمعنى أنها تلقي وعياً على تجارب الإنسان العادي غير المضاءة بالوعي، وتقيم علاقات جديدة في داخل عقل ووجدان القارئ..
إن لهذا معنيين
المعنى الأول:
أن الرواية، والأدب عموماً، هو أهم وسيلة معرفية عرفها الإنسان، حتى قيل أن أكثر من ثمانين في المائة من المعرفة البشرية الحقيقية يأتي عبر الفن.
والشيء الآخر:
أن لكل إنسان تجربته الخاصة، وهكذا فإن تفاعله مع الفن سيكون استجابات وأفكار خاصة به.
إذن:
الرواية تقول مجموع ما يقوله أو يفكر به البشر الذين يفكرون بها خلال أو بعد قراءتهم لها.
من هنا نستطيع القول أن ما تقوله الرواية ـ حتى بالنسبة للأفكار ـ هو لا نهائي ومفتوح للمستقبل، وسأعطي مثالاً على ذلك:
لو أخذنا مسرحية هاملت وسألنا شكسبير ماذا يريد أن يقول، لربما أجابنا أنه يريد أن يقول هذا الشيء أو ذاك. ولكننا نعلم الآن أن هنالك ثلاثة عشر ألف كتاب ودراسة قد كتبت عن هاملت، وكل دراسة من هذه الدراسات تحمل وجهة نظر مختلفة.
معنى هذا أن مسرحية هاملت قالت مجموعة حقائق لا نهائية ـ بمعنى من المعاني ـ وأن شكسبير لم يساعدنا كثيراً في الرأي الذي كان يمكن أن يقوله.
بالنسبة للشخصيات، والمواقف الروائية، لا يوجد روائي ليس له عالمٍ خاص وشخصيات تشكل هذا العالم، وتتماثل بهذا القدر أو ذاك
مثلاً.. لنأخذ دوستويفسكي، هنالك شبه كبير بين غروشنكا في (الأخوة كرامازوف)، وانستاسيا في الأبله, وليزا في الجريمة والعقاب، وشخصيات ليست رئيسة في المجانين. أو لنأخذ بلزاك، إن شخصياته لا تتكرر فقط، بل نراها هي ذاتها في أكثر من عشرين رواية من رواياته، مثل فيتورين ولوسيان وغيرها.
وعندما أفكر بالشخصيات النسائية الإيجابية وفي رواياتي، أرى أنني ـ لظروف خاصة، ولأفكار محددة، ولرؤية محددة أيضاً ـ أرى أنني أستعيد نمطاً بدائياً كانت المرأة فيه تحتوي على كل الوظائف. فأنا هنا بين لا وعي الحاضر واللاوعي الجمعي أصوغ شخصية المرأة.
وقد يقال بتبسيط مخل، وأن ذلك مجرد رؤية أوديبية، ولكن لماذا لم تنتج الرؤية الأدبية عند د. هـ. لورانس مثل هؤلاء النساء..؟!. أعتقد أن ذلك يعود إلى رؤية خاصة بي لا يمكن تفسيرها بالعامل النفسي فقط.
إنني ابن تاريخ مازال حياً في القبيلة البدوية، وفي المجتمع الريفي النصف بدوي، الذي عشته. كما اكتشف هذا النمط في الحي الشعبي المصري، أي أنه لا وعي تاريخي وشخصي يحدد اختياراته بالنسبة لأنماط معينة من النساء.
إننا أمام خيارين:
إما أن نقرأ الأدب كمثال توضيحي لفكرة، فنفقر أرواحنا وعقولنا. أو نقرأه باعتباره الوسيلة الأساسية للمعرفة، أي باعتباره تجربة وقد لاحظت أن معظم الانتقادات الموجهة إلى كتاباتي لا تعترض على فنيتها بقدر ما تعترض على كونها تجربة..
التجربة ـ بالنسبة لإنساننا العربي ـ هي شيء ملوث بالواقع. هي مادة كثيفة لا تكشف الأفكار التي وراءها، لهذا فهي غير لائقة، وتصبح غير لائقة أكثر عندما تخترق جدار المحرمات.
هنالك قضية يجب أن تحسم بقوة في مجال تقييمنا للأدب.. هو موضوع أسميته موضوع الإحالة، أي أن يحال الأدب إلى علم الأخلاق، أو علم السياسة أو علم الاقتصاد، لا أن يحال إلى ذات القارئ.. إلى تجاربه الحقيقية.
إن الإنسان المقموع يخاف حقيقة نفسه، يخاف من طفولة مشبعة بالأوديبية، يخاف من انكشاف اشتهائه لزوجة الجار، يخاف من اكتشاف كذب ادعاءاته بالفضائل المقننة اجتماعياً لذلك عندما يواجه بهذا يستفز إلى أقصى حد. ربما كان هذا هو السبب الذي جعل الكثير من القراء يقولون لي إن رواياتك قد أدخلتنا في كابوس حقيقي، وأنا لا أعتقد أن الروايات هي التي أدخلتهم في كابوس، ولكن الذي أدخلهم إليه هو نفوسهم المقموعة عندما ابتدأت تتحرض.
لنتذكر موقفاً مشابهاً في تاريخنا…
كان الشعر، قبل جماعة من نسميهم بالمجان، هو في غالبه ـ ما عدا استثناءات قليلة ـ عبارة عن تجسيد لأفكار ولقيم اجتماعية، ولكن عندما جاء المجان طغى عليهم الشعر المعبر عن الأحاسيس الجسدية. كان طرفة يشرب الخمرة في الحان، ولا نعرف عن الحان شيئاً،
أما أبو نواس فيصف لنا الحان برائحته، بالأرضية التي عليها “مسارب من جر الزقاق..” من الكؤوس التي عليها.. صور معارك وفرسان، من مراقبة الضوء وهو يتخلل الكأس ليصل إلى وجه النديم، إلى آخره. إذن عند أبي نواس كانت الحواس تعمل وتعبر عن نفسها، كان أبو نواس يطالب بالتعبير عن التجربة المعيشة، وإليك هذين البيتين لأبي نواس:
صفة الطلول بلاغة القدم
فاجعل صفاتك لابنة الكرم
صف الطلول على السماع بها
ذو عيان كأنك في الفهم
ما يريد أن يقوله أبو نواس هنا هو أن شاعر الطلول قد عاش تجربة الطلول فلماذا نكتب عن تجربة لم نعشها، إذن لنقل شعراً عن حياتنا التي نعيشها. حتى في وصفه للمرأة، كان النمط السائد هو وصف المرأة السمينة التي إذا وقفت تحتاج إلى امرأتين تسندانها، وإذا سارت تلهث بعد ثلاثة خطوات، وإذا دخلت الباب لا يتسع لها فتنحرف حتى تستطيع الدخول، وكانت هذه صورة لامرأة سابقة. أما بنت العصر الذي كان يعيش فيه فهي امرأة أخرى، إنها المرأة الواقعية، العاملة، الخبيرة بالحياة، هيفاء القد، التي تتحرك بيسر وسهولة، وأن أجمل نساء العرب والعجم هي تلك الفتاة التي كانت:
انت لرب القيان ذي معاينة
الكشح محترف بالكشح محتسب
وعرفت المرأة الحب، وعرفت الرجال، وعرفت العمل، وعرفت كيف تشق طريقها بالحياة، فأصبحت امرأة لا مثيل لها بين العرب والعجم.
أي أنها المرأة الواقعية وليست امرأة مأخوذة من صياغات شعرية سابقة. لهذا استنكر الناس شعر أبي نواس، واستنكروا أكثر أنه لم يخضع لثنائية العصر،
أن تعيش حياة وأن تكتب باعتبارك تعيش مجموعة من المواضعات. هذه الثنائية هي التي استنكرها أبو نواس وثار عليها، وهي مفهوم أخلاقي. وقد بلغ أبو نواس من الخطورة أن الخليفة طالبه ألا يكتب عن تجربته الخاصة كما طلب من بشار بن برد، وأمره، أن يبدأ قصيدته بالوقوف على الأطلال، فقال قصيدته المعروفة، التي مطلعها:
“دعاني إلى وصف الطلول فسلط..”.
والآن نواجه نفس المشكلة، أن يعبر الإنسان عن الحياة الحقيقية لن يستثير ـ في البداية ـ إلا حنق وتوتر الكثيرين..
▪︎ ألا ترى معي أننا الآن في عصر التبدلات المتسارعة التي تكاد تلغي كل خصوصية، وأننا ـ كتاب هذا الجيل.. ـ ربما هربنا إلى تصور شخصيات، نبنيها من نماذج عدة، في محاولة لبعثها في الحياة.. هل ترى أن هذا صار لازماً حقاً..؟.
▪︎ سبق أن قلت أنني لا أتحكم تماماً في العمل الروائي، أنه يكتب نفسه في الغالب. وبالنسبة للشخصيات يحدث الشيء ذاته، حيث تبرز الشخصية ـ وفي الغالب ـ يكون لها صورة أصلية، أي إنسان واقعي، ثم أرى هذه الشخصية تنمو وتتطور حسب معطياتها هي، ليس عندي الإرادة، أو التعمد، لخلق شخصية روائية، فغالبية شخصياتي لها أصل واقعي، ويحدث في الغالب تفاعل بين الشخصية الواقعية والشخصية الروائية، فهنالك عملية الحدس، فقد تكون الشخصية الواقعية ـ كما حدث مرة بالفعل ـ فتاة متحررة من كل القيود، لا ضابط لانطلاقها، كل من دعاها إلى السرير تستجيب له دون تردد، لكن حدسي جعل هذه الفتاة فتاة محافظة متدينة متمسكة بكل شكليات الدين وطقوسه. وبعد مرور ست سنين على انقطاعي عنها سألت عنها أحد الأصدقاء، وقلت: “هل صحيح أن فلانة أصبحت شديدة التدين، وتمثيل لكل الطقوس الدينية..؟!، فقال لي إنها كذلك بالفعل، ولكن من قال لك..؟!”. لم يقل لي أحد، ولكنني كنت أرى في هذه الفتاة ـ في أشد حالات انطلاقها ـ فتاة متدينة محافظة. الحدس هو الذي يأخذ من الشخصية الواقعية الإمكانيات الروحية، والتطورات اللاحقة
ربما كان الفارق بين الكتابة الذهنية والكتابة التي تعتمد على اللاوعي هو أن اللاوعي فيما يبدو، قادر على استبطان الشخصية الأخرى. أي أنه قادر على إدراك الجوهري فيها وقادر أيضاً ـ وبشكل غير مفهوم ـ على استكناه تطوراتها اللاحقة.
الشخصية تبني بشكل كلي، وأعتقد أنه خارج اللاوعي لا يمن بناء الشخصية إلا بشكل ميكانيكي.
ثمة من يرى في المرأة شخصية تصعب على الإمساك، فطبعها أقرب للتقلب ولا يتكشف لواحدية الرؤية أو التفسير، وعندك في رواياتك تبدو المرأة أقرب إلى الاستقرار وتمضي في سلوكها بشكل مدروس.. كأنه موجه، ما رأيك؟
▪︎حين تحدثت عن الشخصية كنت أعني المرأة، ولكن المرأة مختلفة عن الرجل، لا أعني فيزيولوجياً، ولكن بسبب وضعها. أتعامل مع المرأة ـ بالطبع ـ ليست كما هي، ولكن من خلال ذاتي، أي من خلال سيطرة نمط معين عليَّ، وهو كما قلت منذ قليل ـ متحدر من عصور الأمومة، وأعني به النمط الكلي أو المرأة الكلية التي تجمع بين خصائص متعددة.
إن قوة هذا النموذج مستمدة ـ دون شك ـ من اللاوعي، ولكنها تتعدد من خلال الواقع، أي من خلال المرأة الواقعية. وبالنسبة للمرأة الواقعية أكثر ما يزعجني فيها ـ من خلال تجربتي ـ هو أنها تفقد خصائصها عندما تقيم علاقة مع الرجل، إذ تحاول أن تكون الصورة السلبية لرجل إيجابي، وتكاد تصبح بلا مطالب باستثناء هذه الصورة.
لقد أدهشني هذا كثيراً، فكنت أتساءل لماذا فقدت هذه المرأة كل خصائصها عندما أحبت؟
لماذا لم تعد تحتفظ بشخصيتها الأولى؟!.
فإذن كتابتي عن المرأة لا تنطلق فقط من علاقاتي معها، ولكن من مراقبة المرأة وهي خارج حالة الخضوع. إنني أبحث باستمرار عن تلك الأنماط النادرة التي تتجاوز واقع المرأة المعطى. لذلك أكاد أكون مبشراً بامرأة جديدة، لا انطلاقاً من معطيات إيديولوجية أو ذهنية، بل انطلاقاً من نموذج كامن في اللاوعي. وبشكل ما أن أخلق امرأة نادرة الوجود، ولكنها هي المرأة الحقيقية، وأعني بالحقيقة تلك التي لا تفقد خصائصها أمام الرجل،
وهذا يطرح إشكالية.. وهي علاقة الأدب بروح العصر
فهل نصل إلى روح العصر من خلال تصوير فوتوغرافي للواقع.؟
أم هل نستثير إيجابياته من تراث تاريخي ترسب في اللاوعي؟
▪︎يقول وولتر بنيامين، في دراسة له متميزة عن كافكا، أن التجارب التي يعبر عنها كافكا هي تجارب عصور ما قبل التاريخ، حيث يوجد قانون للحياة الاجتماعية يفعل فعله، ولكنه غير معروف للناس، وهذا يعني تفسيراً جديداً للاوعي، وقد وضع كارل يونغ بعض خطوطه،
ووضع خطوطاً أخرى له أيضاً غاستون باشلا، وهو أن مصدر الأدب ليس اللاوعي الفردي، بل اللاوعي الجمعي المتسرب عبر أقدم العصور، قبل وبعد انفصال الإنسان عن المملكة الحيوانية. وفرويد في كتابه “موسى والتوحيد” يشير إلى شيء من هذا عندما قال إنه ممكن أيضاً وراثة الأفكار عن الأجداد، وقد توصل إلى هذا في أواخر حياته.
نعود إلى المرأة. أن تراثاً هائلاً يضغط عليَّ عندما أكتب عن المرأة، فمن ناحية التجربة الحياتية عرفت المرأة البدوية والفلاحة وابنة المدن المتخلفة الأوروبية، كما عرفت مختلف الأنماط الهستيرية والمسيطرة والواثقة من نفسها.. الخ. وعلى مستوى اللاوعي تلح عليَّ تلك العلاقة البدئية الأسطورية بين المملكة الإنسانية والمملكة الحيوانية، ثم تلك العصور التي كانت فيها المرأة نمطاً كلياً شاملاً يجمع كل الوظائف في داخله.
إن تحليل شخصية المرأة عندي لا يمكن أن ينفصل عن هذه المعطيات. فما السبب، مثلاً، الذي جعل كل بطلات رواياتي بلا آباء، كما أشار إلى ذلك في حديث خاص الكاتب الحلبي الأستاذ حسين بن حمزة
أنا لا أعرف الجواب، ولكن الجواب متضمن في هذه العلاقة مع المرأة.
▪︎أخيراً بودي أن أسألك، هل توافقني على القول بأن القصة العربية والرواية العربية بدأت فعلاً بالتقاط سماتها الخاصة، وأنها في المستقبل القريب ستمتاز عن سائر الفنون بقوة الحضور في الساحة الأدبية.. العربية، والعالمية أيضاً.. إذا أخذنا في الاعتبار نجيب محفوظ كمثال.. مثلاً..؟
▪︎عندما نتحدث عن سمات جديدة للقصة والرواية العربية لن نستطيع التقاطها من نجيب محفوظ، لأن نجيب محفوظ هو امتداد للرواية الأوروبية البلزاكية، ووارث التقاليد العقلانية الأوربية والعربية، والعقل له خصائص شاملة كونية.
إن ملامح القصة العربية الجديدة مرتبطة بحساسية جديدة للواقع العربي، ومقتصرة عليه. وهذه نجدها عند محمد خضير العراقي، أدوار الخراط، عبد الله بهشوني السعودي، سليمان الفياض المصري.. وغيرهم.
هنا نجد الغوص في اللاوعي الأسطوري في استخدام اللاوعي الجمعي وفي العودة إلى الأصول الخاصة، وهذا الاتجاه يأتي كفعل وكرد فعل. كفعل باعتباره غوصاً إلى العمق الذي لا يستطيع العقل والوعي أن يصلا إليه، وكرد فعل لتيار الواقعية الاشتراكية الذي يرى العالم عبر مخطط عقلي متماسك ومنطقي ومقنع.
إننا أمام أدب، أي الواقعية الاشتراكية، يصلح لكل زمان ومكان، أما هذه الخصوصية فلم نجدها إلا من خلال كتاب كيوسف إدريس أو أدوار الخراط، أو محمد خضير.
(أخريات العام 1987).
أجرى الحوار: جمال عبود ـــ منتديات ستار تايمز