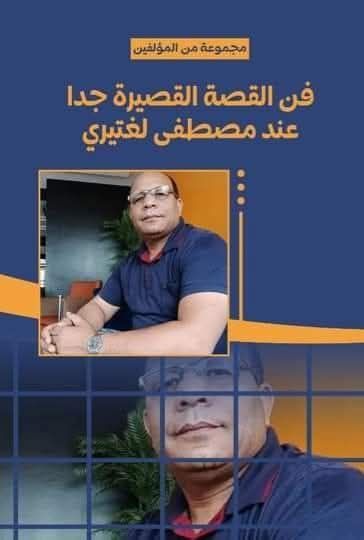كتب عمر العسري
لكل تجربة قصصية إمكاناتها القرائية، ومداخلها النصية التي من خلالها يمكن تبين حدود تحققها واشتغالها، وأيضا ملامسة تحولاتها في مسار الكتابة التي تمثلها. ذلك أن اهتمام القاص بمنجزه النصي راجع إلى التفاته المعرفي، مادامت الكتابة تصرح بخلفية تحمي هوية النص المكتوب، وتحدد نمطا تأليفيا هو ما يسوغ استمرار الكاتب في الكتابة.
كما تتعدد أضلاع التحول الكتابي الذي يكون القاص مدعوا إلى ترجمته، غير أن سند هذا التحول، قد يقترن بتجريب ما يتصور الفعل الكتابي حقلا للتجريب، ومجالا فسيحا لتمرير أفكار ومعارف. ومن هنا يتيح الرصد الذي نلفيه في بعض التجارب، من زاويتي تحديد المدخل القرائي، واستراتيجية الكتابة.
وإذا كان الموضوع في القصة القصيرة يترجم التحول المتحقق، فإنه يعكس التصور الذي انطلق منه، ويحدد، في ذات الآن، مقصد الكاتب. وينطلي هذا التصور على تجربة أحمد بوزفور الذي لم يتخل قط عن الخصوصية القصصية في كتاباته، ولم يجعل المعارف والخبرات الخارجية إلا موضوعا قصصيا لصيقا بهوية الجنس الكتابي. إنها القصة التي تتأمل ذاتها على نحو تترجم أفقها، وتسمح خلاياها من داخل الكتابة، وهذا ما تبدى من خلال حجم التوغل في تأمل آفاق الكتابة أثناء سرد الأحداث والمواقف.
ومن ثم فإن رصد خصوصيات الكتابة القصصية عند أحمد بوزفور، وخاصة في مجموعته «إني رأيتكما معا» يتطلب تتبع المسار الكتابي للمجموعة، وما تحقق سواء على مستوى اعتبار الكتابة موضوعا قصصيا، أومن خلال تبين حدود المواجهة بين القصة وذاتها، أو من زاوية انفتاحها على دلالات خارجية.
الاختبار الموضوعي
تقوم القصة في مجموعة «إني رأيتكما معا» بوظيفة المخاتلة، وإن تكرار بعض المواقف يرقق الشعور والإحساس والقلب، فينخدع المتلقي، ولكن القصة تروض موضوعها الذي تعلو به، فيحظى السرد بميزة خاصة تجعله من خدع الكتابة. وينحاز الكاتب لبيان هوية سرده دون اقتصاره على نص معين، فكأنه يخاتل. وهو يثور على تقليد الطريقة المعتادة لبناء النص القصصي، فإنه ينشئ قصة سريعة الالتقاط تتبيّن حدودها الموضوعية من بنية تقطيعية ومشهدية. للتدليل على هذا الكلام نسوق مقطعا من قصة «الجارية الزرقاء « . يقول السارد: « [..] وحين خرجنا، نظرت الجارية إلى الشاعر وقالت له: إذا أردتني فاطلبني من أهلي في الأرخبيل. أنا حرة ولست أمة… وطارت. أما الشاعر فهاجر إلى الأرخبيل القزحي. ولأن سكان الأرخبيل لم يفهموا طلبه الغريب، ولأن الشاعر مختلف عنهم، فقد توجوه ملكا على الأرخبيل. وأما الخليفة فهام بقصيدة الشاعر، وظل يرددها، وينسج على منوالها، حتى أصبح شاعرا. وأما الجارية الزرقاء، فبقيت كما كانت دائما: (جارية زرقاء) »1.
لقد اكتفينا بالمقطع الأخير من القصة، ويمثل النتيجة التي انتهت إليها، وذلك من خلال علاقة الشاعر بالخليفة، وارتباط الشاعر بالرهان الذي كسبه وحاز من خلاله على جارية زرقاء. وإذا كان موضوع القصة غير مهيأ لتحديد هويته، فإنه يمتلك جزءا مهما للالتفات إلى التراث الأدبي والشعري على وجه التخصيص. وهو اتجاه عام في تجربة أحمد بوزفور استطاع من خلاله أن يستضيف في رحاب القصة القصيرة فنون التراث.
لقد صار التراث السردي وجها من وجوه تأويل الحاضر وفهمه وتعميق الوعي بتعقيداته المختلفة، كما غدا كذلك شكلا من أشكال التمويه الفني الذي يسعى على إكساء السرد القصصي غموضا يجعل إبداعه تداولا بين مقاصد منتجه ومتلقيه، فليس من شأن القاص أن يكشف مقاصده كشفا يذهب بلذة المفاجأة ومتعة الاكتشاف والإدهاش.
إن تنزيل العوالم التراثية والخرافية والأسطورية في صلب واقعنا المعيش، هو استراتيجية سردية دأب عليها أحمد بوزفور في معظم مدونته القصصية، إلى درجة أن الواقع المستهدف صار أكثر إدهاشا من العوالم المفارقة ذاتها. وكأن القاص يريد أن يقول إن الواقع المعقد أضحى في كثير من الأحيان غير قابل للفهم، خارق لكل قواعد المنطق العقلي وأعرافه.
تتجه إذن القصة إلى موضوعها ليس باستضاءته، وإنما بتعتيمه وخرق مرجعياته المعيشية، وخلق واقع بديل مسنود بالمعرفة التراثية والبصرية، لكنه ملتبس من جهة تحديد وجهته. لأن الحياة المعاصر فرضت على الإنسان النظر إلى واقعه نظرة أخرى يسري فيها التشعب مسرى الماء على صفيحة زجاجية.
جاء في قصة «القنفذ» قول السارد: « يخرج في الصباح من الدار. يجوب شوارع المدينة دون هدف. يقف أحيانا أمام بعض الواجهات ليتأمل ذاته، كما يبدو، لأنه لم يكن يهتم بالمعروضات. يرى وجهه المنعكس في زجاج الواجهة، وينفذ منه إلى الداخل. داخله هو. وأنا وراءه. أركز عيني على رأسه، وأحاول أن أتبعه. أن أنفذ، متسللا وراءه، إلى داخله »2.
تسترسل القصة، وهي أطول قصة في المجموعة، في سرد وقائع وتفاصيل وفق مواضعات ومواصفات معلومة، وليس من شأن القصة القصيرة، في هذا المقام، أن تنقل الواقع، إنها تُنشئه وفق رؤية كاتبها، وتعبث بنظامه وتنتهك حدوده وتنزع عنه كل الثوابت. وهذا ما يجعل القصة لا تتجه إلى موضوعها، وإنما تطور من ذاتها في تأمل تحققها النصي. إن الإسقاط التراثي، والذاتي قد طور طريقة اختبار قصة أحمد بوزفور لموضوعها، ووشّى الواقع الإنساني بالرمز، مما غير من صورة الواقع لتصبح القصة أكثر تعبيرا من الواقع، أو كما يقول إنريكي أندرسون إمبرت: « يوجد لدى كل إنسان تصور عن العالم، وعندما يكتب قصة قصيرة يقوم الإنسان، الكاتب، بتعديل هذا التصور ذلك أن مقصده فني وليس منطقيا. ففلسفته الشخصية عن الحياة تعود للظهور وقد حدث عليها تعديل لتظهر هكذا في عقل الراوي. ويقوم هذا الأخير بدوره بإدخال تعديل آخر ليرسم نمط تفكير هذه الشخصية أوتلك»3.
إذن فالقصة القصيرة، بحسب هذا المنطلق، وبما اقترحه علينا أحمد بوزفور، تختبر موضوعها بتجريب فكرة عن الحياة، وهي معطى سردي لا يطلب مسارا منطقيا، أو فكرة مهادنة، وإنما تقتضي التواري خلف معطيات خارجية ورموز مقابلة للوقائع والأحداث. ومن شأن هذه العلاقة، بين القصة والموضوع، أن تعيد النظر في تداخل وتخارج العلاقة من زاوية الطرح والتناول، وقد لا يدع مجالا إلى استلهام ما يجيب عن أسئلة كثيرة تقرن الكتابة القصصية بالتفاتها المعرفي واشتغالها اللغوي.
القصة المنشطرة
لم يكن ممكنا ملامسة جوهر قصص المجموعة إلا بالتوقف عند المشهدية التي خلقتها، وقد تبدت كلقطات موجِّهة لدفة الحكي. وأصبحت إجراء نصيا في بعض القصص إن لم نقل جلها. وقد ساهم في هذا التحقق وظيفة البطل القصصي وظلاله. ويمكن للقارئ أن يجد نفسه حيال تداخل بين البطل ومناوئه. وهذا المنظور النوعي والتقني هو الذي أعطى للقصة انشطارها وتناثر تفاصيلها.
فقد أفلح الكاتب في البناء السردي لحدث قائم على مشهد صغير كأنه مشهد سينمائي، إذ تتحول عين الكاتب إلى كاميرات تلاحق مشهدا مثيرا بأربع سيناريوهات. وهو ما تحقق في قصة « نلتقي حيث نفترق « على سبيل التمثيل. تحكي القصة عن شخصية تلقّت دعوة غريبة وتوقفت بها الحافلة عند الكيلومتر 87. وتصوغ القصة أربعة سيناريوهات لمسار الحدث، سماها الكاتب البديل الأول، الثاني، الثالث، والرابع. عمد السارد في بداية القصة إلى تحديد الحالة البدئية لها. وانتقل بعدها إلى رصد واقع الشخصية مؤولا فيه بطولة الإحساس والموقف إلى ضمير المتكلم. جاء في البديل الرابع من القصة قول السارد: « لم أكن قد سرت أكثر من بضعة كيلومترات حين لمحتهم. مجموعة من الرجال والنساء يتحركون بين خيام منصوبة، وفي أيديهم آلات مختلفة. سلمت على أول رجل لقيته، وقدمت له بطاقة الدعوة، فقادني إلى رجل آخر قال لي إنه المخرج. قرأ المخرج بطاقة الدعوة، ثم نظر إلي لحظة قبل أن يبتسم ويمد لي يده مرحبا. قال لي إنني مدعو إلى المشاركة في تمثيل شريط سينمائي، وإنهم قد بدأوا في التصوير هذا الصباح..»4.
إن مركز القصة هو الدعوة الغريبة التي يستطيع أن يقرأها كل من فتحها، وهي رسالة وحيدة موجهة إلى أربع شخصيات، وكلهم معنيون بها. فهي تخاطب ذواتا متعالية في القيمة والمعنى، لأن مرسلها معلوم ومجهول ومعلوم في آن. السيناريوهات التي تعمدت القصة طرحها، تضع البطل موزعا على أربعة أدوار، أو بالأحرى احتمالات الوصول إلى الهدف. فهذه الدعوة الغريبة مصيرها عودتها إلى صاحبها في نهاية المطاف.
ينم هذا الانشطار، أو تعدد المنافذ، عن فكرة خاصة بأحمد بوزفور تجاه الحياة، فهو يريد صدّ الموت بنقيضه، ويكوّن موقفا من المسار الحياتي الفردي، فالحياة بنت الحاضر والموت ابن الغيب أو المستقبل كما يقال. والقصة ترهن كيانها بالانشطار والتفرع وخلق بنيات سردية موزعة داخل الجسم النصي الواحد، وهو ما تحقق في قصة «الجارية الزرقاء» التي تتوزع بين ثلاث قصص؛ سرد الخليفة، سرد الشاعر، وسرد الجارية الزرقاء. ورغم كون السارد يتحكم في تلابيب السرد، أو نقل السارد المحقق في القصة البوليسية على سبيل المقايسة.
تكشف القصة المنشطرة أن الكتابة عند أحمد بوزفور لا تقبل الوجهة الوحيدة، ولا ترهن الحدث القصصي لخطية كلاسية، فهي قصة تبني وتحطم، وتنتهك حجب المخفي، وتسبر غور الذات والنفس، هي قصة فوضوية الرؤية بطلها لا يستقر على حال، ولا يرى في الحياة ما يستحق أن يعيش لأجله، ترتاد بنا إلى عوالم غرائبية، وهذه مفارقة أخرى من مفارقات القصة عند بوزفور.
وأنت تقرأ قصة « نلتقي حيث نفترق « تحس أن الكاتب يريد التغلب على إحساسه وعلى الصورة القاتمة للموت بالصورة المضادة التي تتعزز فيها عبثية الحياة، أو إنه يريد أن يحقق الفرضية الجمالية التي تصدق عليها فكرة الوجود كعدمه، ميت ولذلك فهو يعنى بأضداد هذه الفكرة.
الحياة، من هذا المنظور الفكري والقصصي، لا تستحق كل هذا الانصياع وكل هذه الصرامة، وإنما تستلزم تنويع النظر إليها وفيها، ووضع سيناريوهات لا ترى في الفرد نفيا للآخر بقدر ما تنظر إليه كبديل وجودي ينطوي على مرجعية وخبرة حياتية، ويكفي أن تكون البدائل السردية للقصة الوحيدة صياغة للوعي الإنساني ووضعياته المختلفة والمحتملة والوقوع. ولن يتأتى هذا إلا لكاتب مجرّب وخبير بحرفته القصصية، وقد قال القاص المصري يحيى حقي عن الكاتب بهذه الصفات: « الكاتب اليوم مكلف أن يعيش في مستوى عالمي وألا يفقد صلته مع ذلك بأرض وطنه ومحيط أهله. ولن يقوى على ذلك إلا من كانت له روح غنية، وذهن منفتح وقلب عامر بالعواطف كلها.. هذا عبء يحتاج إلى جهد كبير، وصبر لا ينفد، وشجاعة للتضحية بالعابر والتافه من أجل ما أسمى وأبقى.. «5.
بالفعل فكاتب القصة القصيرة غير مطالب بنقل الوقائع كما هي، وغير مقيد بمنطق الأحداث، وإنما يخضع عالمه القصصي لـ « تنسيق درامي محكم للحدث بطريقة تعرض توتره الدرامي وتجعله محسوسا «6.
ينسجم هذا الكلام مع رهان القاص على إعادة ترتيب العلاقة بين داخل الحدث وخارجه، فالأحداث في القصة ليس لها موقعا خارجيا بل هي عين السارد، لأن القصة تبدأ بالتفقير العلاماتي أو الرقمي كاختيارين لمعمارية النص. فكل القصص تجسد هذا الانشغال بالرؤية الانشطارية، ومن ثم فإن رصد تحول القصة الواحدة إلى قصص فرعية، أو تناسل الأحداث من الحالة البدئية، هو ما نزعم تحققه في المسار الكتابي لأحمد بوزفور.
هكذا، تضمن القصة انفتاحها وانشطارها، ليس بوصفها موضوعا فحسب، وإنما إرجاؤها إلى تباينها الضمني، وانسجامها الكتابي، وقد تجلى هذا في ما اقترحه علينا الكاتب في قصة «ما» التي انشطرت إلى أربع فقرات: شيء ما، شخص ما، فكرة ما، وأنا ما. وهذا أنموذج على تحول النص المفتون بلعبة القصة المنشطرة المتفرعة إلى تنازع كتابي قائم لذاته، ويكشف عن تحول هذا النمط السردي إلى فتنة موغلة في البحث عن الإبهام والتجريب والامتداد من داخل الكتابة.
القصة والحلم
تواصل مجموعة «إني رأيتكما معا» خلق تصور عن الكتابة القصصية وممارستها، غير أن الكاتب، يختار مواجهة القصة من الداخل، وهو موقع مهم يكشف عن ارتباطها بأفق مجرد تؤشر عليه البنية البدئية لمعظم نصوص المجموعة. على نحو ما جاء في قصة «ذلك الولد الغريب». يقول السارد: « كانت تحلم بأنها حامل. تحلم أحيانا أنها ولدت الطفل. طفل جميل ناعم الشعر والبشرة.. ويبتسم. لكن له ذيلا. ذيل صغير كذيل جدي، وبشعر قصير أيضا. شعر ذيله ناعم كشعر رأسه. ما أن تمسكه بيدها حتى يبتسم الطفل.. كأنها تدغدغه. تحلم أحيانا أنها نسيت الطفل في السوبرماركت. وحين تعود إلى السوبر تجده في علبة عليها ثمن البيع. ثمن بالملايين. ماذا تفعل لتسترده؟ »7.
يومئ هذا المقطع إلى وضع حياتي غرائبي، يلامس حياة غير معهودة، وهذا جانب آخر قد لا يعنينا في تبين وجهة القصة ومقصدها. لكن المتحقق تقاطع القصة، وكثير من قصص المجموعة، مع الحلم والرؤيا، وبذلك تُدرج النصوص دلالتها وبنائها بحسب مواقع محددة، قد تكشف عن خبايا أخرى في الفعل الكتابي الذي يسمح بالاقتراب من مجهوله.
دلالة الحلم الذي يشدد عليه هذا المقطع مرجح أن يجيب عن أسئلة مضمرة في تنصيص القصص على اليقظة الدائمة، فهي ليست نقيضا للنوم والغفوة، بل تحكمهما ارتباطات خفية هي ما يسمح برتق موقع السارد الرؤيوي. فقد قال السارد في قصة «السن الذهبية» وهي تعكس حالات السارد الحلمية في ثلاثة مشاهد. «رأيته أول مرة في مرآة. المرآة تغطي مساحة كبيرة على الجدار. أنظر إليها كل صباح، وأنا أغسل وجهي، أو أنا أحلقه[…]في المرة الثانية رأيته في السوق المركزي. رأيته من بعيد. كان هو يشتري سمكا، وكنت أشتري خضرا. وفوجئت بكونه يلبس بذلة حديثة هذه المرة، ويعتمر بيريه أسود كبيريهات المثقفين. […] أما المرة الثالثة والأخيرة، فرأيته في المنام: رأيتني داخل سيرك. القاعة مليئة بالناس من كل الأجناس والألوان والأعمار…»8.
يعضد فعل «رأيته» التداخل القائم بين القصة والحلم، غير أن ثمة يقظة مفتعلة في النوم دون أن تحتفظ بمعناها المألوف. بل إن تخلي القاص عن الموجّهات الدالة على هذا هو ما يسمح بافتراض التداخل المتحقق، وهو تداخل يضيء تجربة السارد الحلمية باعتباره القرين المضاعف للكاتب الذي يترجم حالات حلمية ديميترية.
إذن فالصحو في قصص المجموعة شكل من أشكال الحلم الذي تسمح به الكتابة من الداخل، وذلك لما ينطوي عليه من مشهدية سردية مفتوحة على وجوه وحالات يقدمها السرد عبر أقنعة، وإن لم تكن كذلك في حقيقتها المرجعية. وقد نحس باندساس السارد في رؤياه ليس إلا عثورا على وجه من وجوه ذات الكاتب، فلا وجود لحلم خارج هذا السياق.
تقدم لنا مجموعة «إني رأيتكما معا» في بعض نصوصها، أنموذجا بارزا على السرد المكتوب بلغة رمزية، وميزة هذا أننا نجد فيها « كما في كثير من الأحلام، أحداثا متعاقبة قد يكون كل منها على حدة حدثا عينيا وممكن الحصول. غير أن هذه الأحداث بمجملها تعتبر أحداثا خيالية مستحيلة «9. في الكتابة كما في الحلم تكف الوقائع عن أن تحتفظ بماديتها، فالأشياء والعناصر تنفصل من وضعها المألوف كما يومئ إلى ذلك تكرار بعض الكلمات.
ثمة، في القصة، نفي للواقع، ومع أن الكاتب اعتمد معجما ذا مسحة افتراضية، فإنه هذا يشتغل دلاليا على محو واقعية الأحداث والعمل على ترميزها بفسح إمكانية حدوثها كما جاء في قولة إيريك فروم في معرض استجلائه لخصوصية بطل رواية المحاكمة لفرانز كافكا. وقد خلص إلى أنها رواية تثير العجب وتبدأ بالحلم الذي يترجمه المعجم الموظف.
ويتضح أننا في الواقع أمام قصص في قصة واحدة، صيغت بوعي تماثلي وتجاوري يتجسد في لغة رمزية تُسائل البعد الحلمي للسارد المتعدد والمنخرط في رؤياه. وهذا التشكل المتعدد يتمحور حول عمق الفجوة التي ترهن الوقائع، وبالرؤية الحلمية تعلي القصة خيطها الرابط اللام للصورة وللأداء، وكأن السارد الضمني في كل مقطع سردي يستدرك متبينا أنه يملك خيارات وبدائل لا تساوم على الحياة في تحققها، وإنما في شرط إمكان حدوثها على الصورة التي صيغت لها.
ولأن مجموعة «إني رأيتكما معا» هي قصص تفكر في ذاتها بوعي اختبار الموضوع وتشطير السرد وترميزه، فإنها بحسب غاريث غريفثس، هي كتابة تقدم طرقا جديدة للاقتراب من مشكلة الشكل التام للمعنى. وهي نقطة رئيسة تثير مسألة كلية قد لا تنطبق على جل الكتابات، وإنما تعنى بالأساس تطوير الموروث الشفهي، وأصالة معالجة اللغة والشكل السردي10.
استطاع أحمد بوزفور أن يجعل من قصصه فضاء رحبا لتفاعل الأجناس، وهذا مدخل قرائي آخر، ومجالا لاستدعاء رؤيته الكتابية التي تجدد التعامل مع هذا الجنس بغاية إثبات ذات كاتبة تحاور فكرها القصصي وكيف يمكن أن يتحقق، وهو سعي مستمر أبانت عنه مجموعة «إني رأيتكما معا» بتنزيل خصائص تعمق الوعي بالكتابة على اعتبار أن أي شيء في هذه القصص قد سمح ب:
مواجهة القصة لذاتها، خلق التقابلات السردية، تناسل الحدث من سابقه – اختزال الحلم واقترانه بوسائط التصريح بالنوم ونفي اليقظة، توثر المكونات البانية،
تقطيع السرد وخلق صور القصة
إنها قصة لا تفتأ أن تناوش خلفيتها المعرفية وتستفز جنسها رافضة الانضواء تحت خط كتابي قار، لأنها نزّاعة إلى ارتياد المناطق المجهولة أحيانا، وكشف العوالم المحتجبة، وهي جديرة بزعزعة اطمئناننا ودفعنا إلى محاورتها ومساءلتها عن منطلقاتها الكتابية وغايات احتفائها المستمر بعقد المفارقات والبحث عن التوازن في اللاتوازن.
إن البحث عن الأفق الامتدادي للقصة عند أحمد بوزفور، قد سمح منهجيا بالتوقف عند مواقع ومداخل تلامس تصورات عن الكتابة في اختبار الموضوع، وتقطيع السرد، وتمجيد الحلم. وهو ما يفسر كون القصة، بهذا المنطلق، تثمن دورها وجوهر الكتابة القصصية المعاصرة. فهي تضيء مسارها من الداخل، وتنصت إلى القصة انطلاقا من القصة ذاتها، وهو ما يفسر تنازعا جماليا محوره استراتيجية الإحلال والإزاحة. وهما حركتان يروم القاص إدماجهما في بناء تصورات، على نحو يكشف عن دور التجربة الحيوي في إنتاج ما تعجز عنه المفاهيم التي تهدد مسار الكتابة القصصية.
الإحالات
أحمد بوزفور، إني رأيتكما معا – قصص، دار توبقال للنشر – الدار البيضاء، ط/1، 2020، ص. 39.
نفسه، ص. 11.
إنريكي أندرسون إمبرت، القصة القصيرة: النظرية والتقنية، ترجمة: علي إبراهيم علي منوفي، المجلس الأعلى للثقافة – مصر، ط، 2000، ص. 116.
إني رأيتكما معا، ص. 53.
يحيى حقي، فجر القصة المصرية، نهضة مصر، ط/1، 2008، ص. 148.
تشارلز ماي، القصة القصيرة: حقيقة الإبداع، ترجمة: ناصر الحجيلان، الانتشار العربي – بيروت / النادي الأدبي بحائل – السعودية، ط/ 2011، ص. 270.
إني رأيتكما معا، ص. 29.
نفسه، ص. 57 – 58.
إريك فروم، اللغة المنسية مدخل إلى فهم الأحلام والحكايات والأساطير، ترجمة: حسن قبيسي، المركز الثقافي العربي – الدارالبيضاء/ بيروت، ط/1، 1995، ص. 224.
غاريث غريفثس، المنفى المزدوج الكتابة في أفريقيا والهند الغربية بين ثقافتين، ترجمة: محمد درويش، كلمة – ثقافة – الإمارات، ط/1، 2009، ص. 157.
الكاتب : عمر العسري / شاعر وناقد
بتاريخ : 11/09/2020