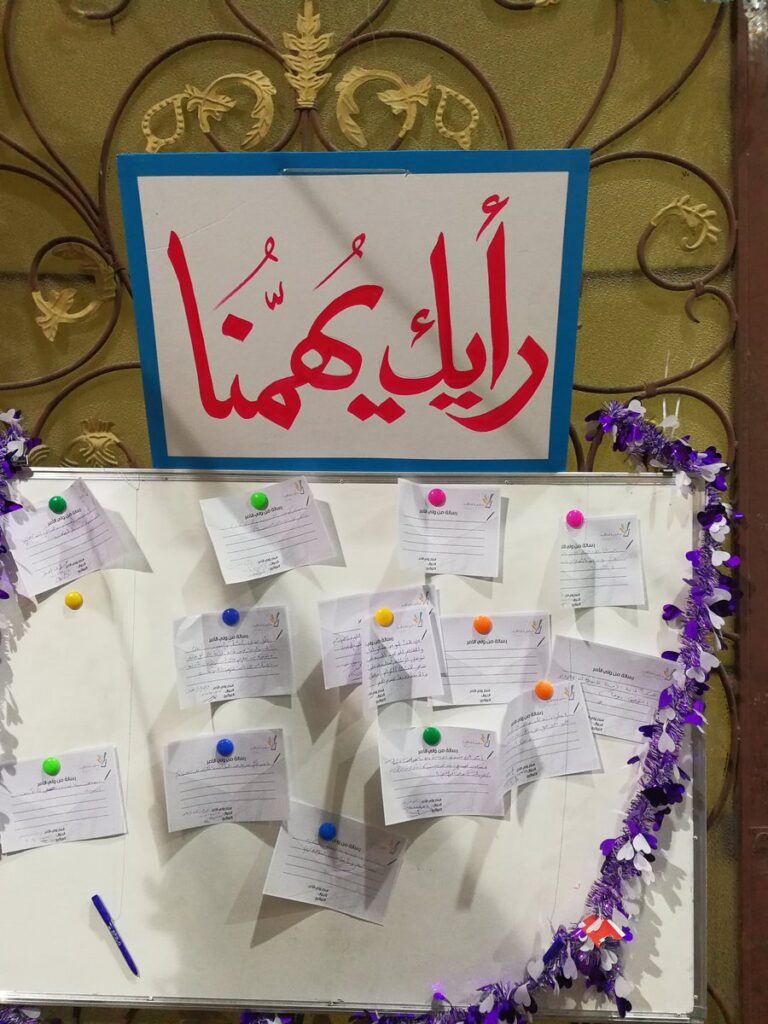تزفتان تودوروف وفضيلة
النقد الذاتي
قراءة في كتاب “الأدب في خطر”
■ إدريس جنداري.
1- خطاب الأدب، من التعبير عن جوهر الإنسانية إلى التهميش:
إن ما ميز الإبداعات الأدبية العظمى، على امتداد التاريخ البشري، هو قدرتها الفائقة على التموقع، باعتبارها كيمياء الحياة الإنسانية، على المستوى الفردي السيكولوجي والجماعي السوسيولوجي. وباعتبارها كذلك، فإن الذات المبدعة التي تحملت مسؤولية الكشف عن الكينونة الإنسانية المنسية، بتعبير ميلان كونديرا، جسدت دائمًا قدرة إبداعية لا متناهية، لم تكن أقل كفاية وقدرة ومهارة عن كبار رموز الفكر والعلم. لذا لا يمكن التمييز بين الأسماء الفكرية والعلمية والإبداعية الكبرى، فعبقرية الروائي الروسي تولستوي أو الشاعر الفرنسي بود لير لا تقل عن عبقرية الفيزيائي الرياضي أينشتاين والفيلسوف نيتشه أو المفكر ميشيل فوكو.
لقد كانت هذه هي القناعة التي وجهت البحث الإبستملوجي خلال مراحل تشكله الأولى، لأنه استبدل بموضوع التفكير البحث في الآليات المتحكمة في فعل التفكير؛ بمعنى إن الآليات نفسها التي تتبلور على شكل كفايات يمكن تجسيدها في الممارسة الفكرية الفلسفية بطابعها النظري الخالص، كما يمكن تجسيدها في الممارسة الإبداعية بطابعها التخييلي، ويمكن تجسيدها على مستوى الممارسة العلمية بطابعها التجريبي، في الآن نفسه. إن مكانة الأدب في تاريخ العلم تكمن في قدرته على سبر أغوار النفس الإنسانية، وهذه الوظيفة تعجز كل العلوم عن القيام بها. وعلى الرغم من القدرة الاستكشافية التي يتميز بها علم النفس في هذا المجال، فإنه ظل مرتبطًا بشكل وثيق بخطاب الأدب، سواء تعلق الأمر بالتوجه الإكلينيكي الفرو يدي، أو تعلق الأمر بالتوجه التحليلي مع كارل يونغ، إذ كانت النصوص الأدبية منطلقًا لاستكشاف التفاعلات النفسية في بعدها البشري العام.
وعلى الرغم من هذه القدرة الخارقة للإبداع الأدبي على سبر أغوار النفس الإنسانية؛ فإنه تلقّى صدمات متتالية جعلته يندحر إلى آخر الترتيب في سلم العلوم والمعارف الإنسانية. وقد كان ذلك نتيجة مباشرة للتأثير السلبي الذي مارسته الحداثة في بعدها التقني، وقد تجاوز هذا التأثير مجال الإبداع الأدبي إلى مجال الفلسفة، بل وصل التأثير إلى مجال العلوم، التي دخلت في سيرورة جديدة اقتربت بها من مستوى الحِرْفية والمهننة، بعد أن حاربت بعدها النظري التجريدي الذي ميّز معظم التخصصات العلمية عند تأسيسها، إنها مرحلة المفارقات القصوى بتعبير ميلان كونديرا، مرحلة تولد من جديد وتؤسس ميلادها “متناسية الإنسان وكينونته، غارقة في خضم المعارف المتخصصة، التي تسعى وراء تحقيق الإنتاج دون أي شيء آخر.”[1]
2- تزفتان تودروف، المسألة الأدبية من المقاربة النقدية إلى المقاربة الفكرية:
يتم تقديم تودروف عادة، رغم أصوله ونشأته الأولى في بلغاريا، بوصفه أهم المفكرين والنقاد الفرنسيين المعاصرين، ولا يرتبط الأمر هنا بجنسيته الفرنسية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى كونه من بين رموز الفكر والنقد الذين مارسوا تأثيرًا حادًا على الثقافة الفرنسية المعاصرة، وذلك ما يؤكده ارتباط اسمه بمؤسسات أكاديمية فرنسية أصيلة وفاعلة في المشهد الثقافي الفرنسي. فبالإضافة إلى إشرافه على مجلةpoétique مع “جيرار جنيت” لمدة عشر سنوات، فهو ينتمي كذلك إلى المركز الوطني للبحث العلمي ( (CNRSإذ قضى فيه كل مساره المهني، كما أنه عضو في لجنة استشارية متعددة التخصصات تابعة لوزارة التربية الفرنسية، فشارك ما بين 1994 و2004 في المجلس الوطني للبرامج.[2]
أما اهتماماته النقدية في مجال الأدب، فيعتبر من رموز المنهج البنيوي في فرنسا، إلى جانب كل من رولان بارت وجيرار جنيت، وقد بلور نزوعه البنيوي هذا، من خلال مشاركته لجيرار جنيت في الإشراف على مجلة poétique التي تعد صوت البنيويين، كما زكّى ذلك بتوجهه إلى مجال الترجمة الذي وظفه ضمن اهتمامه النقدي نفسه، إذ عمل على ترجمة نصوص الشكلانيين الروس في مجلد بعنوان “نظرية الأدب” صدر سنة 1965 وبالإضافة إلى ذلك فقد قدم مجموعة من الدراسات النقدية، كان موضوعها المشترك هو محاولة العدول بتدريس الأدب في الجامعة لتخليصه من شبكة الأمم والقرون، وفتحه على ما يربط الأعمال الأدبية بعضها ببعض، كما يؤكد تودروف في الكتاب موضوع الدراسة.[3]
لكن رغم صورة الناقد والمنظر البنيوي التي لازمت تودروف، فإنه عبر بشكل متواتر عن شخصية المفكر، في “روح الأنوار” و”فتح أمريكا” و”أعداء الديمقراطية الحميميون”… إلخ، وكلها كتب توسع مجال اهتمام تودروف، وتجعله في صلب الانشغالات الفكرية والسياسية التي يعيشها العالم المعاصر.
يحدثنا تودروف عن اهتماماته الفكرية، فيقول: قرأت في كتابي conquêt de l’Amérique، محكيات الرحالة والغزاة الإسبان في القرن السادس عشر، كي أعرف كيف تتلاقى ثقافات شديدة الاختلاف، تمامًا مثل محكيات معاصريهم الأزتيك والمايا. وانغمرت من أجل التفكير في حياتنا الأخلاقية في كتابات المعتقلين والمنفيين سابقًا في المعسكرات الروسية والألمانية، مما دفعني إلى كتابة face a l’extrême. وقد أتاحت لي مراسلات بعض الكتاب فيles aventures de l’absolu مساءلة مشروع وجودي يقوم على تسخير الإنسان حياته في خدمة الجمال.[4]
إن هذا التداخل بين الاهتمامات الأدبية، في صيغتها البنيوية، وبين الاهتمامات الفكرية في بعدها السوسيولوجي والسياسي والتاريخي، كان يوحي منذ البداية بأن مسار حياة تودروف لا يتوافق مع التوجه البنيوي الشكلاني، لأنه ولد ونشأ في بلد شيوعي يولي الفكر والإيديولوجية قيمة كبرى، هذا أولاً، وثانيًا لأن توجهه البنيوي لم يكن اختيارًا متحكمًا فيه عن وعي مسبق، بل كان، أكثر من ذلك، بمثابة رد فعل على الاختناق الذي عانى منه في بلده الأصلي قبل أن يلتحق بالمشهد الأكاديمي والثقافي الفرنسي. ونجد هذا التفسير مبثوثًا في ثنايا كتابه “الأدب في خطر” إذ يؤكد تودروف: كانت بلغاريا آنئذ جزءًا من الكتلة الشيوعية، وكانت دراسة الآداب القديمة توجد في قبضة الإيديولوجيا الرسمية، وكان نصف دروس الأدب علمًا متعمقًا والنصف الآخر دعاية، والأعمال الأدبية الماضية أو الحاضرة تقاس بمقياس التوافق مع العقيدة الماركسية اللينينية.[5]
لقد كان السؤال الفكري لدى تودروف، منذ البداية، بمثابة المكبوت الذي كان خفيًا خلال المرحلة البنيوية، لكنه سيعود بشكل مفاجئ، إما من خلال الممارسة الفكرية المباشرة، وكذلك من خلال الدخول في صيرورة نقد ذاتي في علاقة بخطاب الأدب بدأت خلال سنة 1984من خلال كتاب “نقد النقد”، إذ أعلن تودروف بشكل صريح عن قصور المنهج البنيوي في مقاربة الظاهرة الإبداعية، إذ يشكل الكتاب تحولاً جذريًا، كما يشكل عودة نحو الإنسانية، كما يؤكد Bertrand poirot Delpech[6]، وقد ظل هذا الهاجس يسكنه باستمرار إلى أن أعلن صيحته سنة 2007 من خلال كتابه “الأدب في خطر”.
3- الأدب في خطر، المفكر الموسوعي ينتصر على الناقد البنيوي:
3-1- اختزال عبثي للأدب:
يتوقف تودروف عند تجربة تدريس الأدب في التعليم المدرسي، إذ يصف بشكل صريح الآثار الكارثية التي خلفتها المقاربة البنيوية للنصوص الأدبية، هذه النصوص التي تحولت من تجربة حياتية خصبة وحية إلى أشكال فارغة من المعاني تشبه، إلى حد بعيد، المعادلات الرياضية الجافة برموزها وأرقامها. لقد تجاوز تودروف، وهو يصرح بكل هذا، وظيفته منظرًا وناقدًا بنيويًا كان من المساهمين في الوضعية الجديدة لخطاب الأدب. ولذلك، فهو يعايش هذه التجربة من منظور الأب الذي يعايش أبناءه، وهم يواجهون صعوبات جمة في التعامل مع النصوص الأدبية، وذلك باعتباره مشاركًا ضمن المجلس الوطني للبرامج في لجنة استشارية متعددة التخصصات تابعة لوزارة التربية الوطنية في الفترة ما بين 1994 و2004. وهكذا يخلص إلى أن فكرة عن الأدب مغايرة تمامًا توجد في الأصل، ليس من ممارسة بعض الأساتذة المنعزلين فحسب، بل من نظرية هذا التعليم والتعليمات الرسمية المؤطرة له. [7]
ويخلص تودوروف، عندما يعود إلى الوثائق التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية في فرنسا، إلى أن مجموع التعليمات تقوم على خيار أن الهدف الأول للدراسات الأدبية هو تعريفنا بالأدوات التي تستخدمها تلك الدراسات، فلا تسوق قراءة القصائد والروايات إلى التفكير في الوضع الإنساني والفرد والمجتمع والحب والكراهية والفرح واليأس، بل للتفكير في مفاهيم نقدية تقليدية أو حديثة. فلا نتعلم في المدرسة عماذا تتحدث الأعمال الأدبية، وإنما عن ماذا يتحدث النقاد. ويبعث تودروف تحذيرًا، في النهاية، في غاية الأهمية، ينم عن استشعار كبير بالخطر، وينم عن شجاعة أدبية كبيرة من ناقد بنيوي كبير. إن الطريق الذي يسلكه التعليم الأدبي اليوم، والذي يدير ظهره لهذا الأفق، أفق معرفة الأدب لتحقيق اكتمال الإنسان، يجازف بأن يسوقنا نحو طريق مسدود، دون الحديث عن أن من العسير عليه أن يفضي إلى عشق الأدب.[8]
3-2- ما وراء المدرسة:
ينطلق تودروف من سؤال إشكالي يوضح الوضعية الكارثية التي وصل إليها الأدب في مجال التعليم المدرسي، وهو: كيف صار التعليم المدرسي للأدب على ما هو عليه؟ يتجاوز تودروف، في مقاربته لهذا السؤال الإشكالي، مجال التعليم المدرسي، وكذلك مجال السياسة التعليمية التي تضعها وزارة التربية الوطنية. إن الإشكال الحقيقي، حسب تودروف، يرتبط بالتحول الذي حدث في التعليم العالي، الذي يقوم بوظيفة تكوين أساتذة المدارس، إذ هيمنت البنيوية على جيل كامل من ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ويصرح تودروف بكامل الشجاعة الأدبية بأنه قد شارك في هذه الحركة، ويتساءل: أينبغي لي أن أحس نفسي مسؤولاً عن حال المادة التعليمية اليوم؟[9]
بعد تفسيره للوضعية الجديدة التي يعيشها الأدب، يحاول تودروف توضيح وجهة نظره، حسب القناعة الجديدة التي وصل إليها، إذ يعتبر أن المقاربة الداخلية؛ أي دراسة علاقة عناصر العمل الأدبي فيما بينها، ينبغي أن تكون مكملة للمقاربة الخارجية، أي دراسة السياق التاريخي والإيديولوجي والجمالي. وفي هذا السياق يؤكد تودروف أن الجانب السلبي في التعامل مع النص الأدبي، من منظور منغلق، لا يذهب بعيدًا، فلن يكون أبدًا سوى دراسة أولية، لأنه يقوم بالضبط على ملاحظة المقولات المشتغلة في النص الأدبي والتعرف عليها، لا على أن يحدثنا عن معنى النص.[10]
ولكي يؤكد تودروف على المنحى السلبي للتوجه البنيوي المنغلق، الذي يحاول فصل الخطاب الأدبي عن حركية الحياة بجميع تجسيداتها، يلجأ إلى الدراسة الميدانية التي تؤكد على التراجع الكبير عند الناشئة، فيما يخص التوجه نحو التخصصات الأدبية، وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على التلقي الأدبي بصفة عامة ويفرغ الأدب من رسالته الخالدة، أي تحقيق اكتمال الإنسان. يقول تودروف: يتعلم تلاميذ الثانوي العقيدة القائلة بأن الأدب لا صلة له بسائر العالم، ويدرسون علاقات عناصر العمل الأدبي فيما بينها وحدها، مما يسهم في انعدام الاهتمام المتزايد لهؤلاء التلاميذ بالشعبة الأدبية، فانتقل عددهم في بضعة عقود في فرنسا من 33% إلى %10 من جميع المسجلين في البكالوريا العامة، ويعلق تودروف: ما جدوى دراسة الأدب، إذا لم يكن ألا إيضاحًا للوسائل اللازمة لتحليله؟ وبالفعل يجد طلبة الآداب هؤلاء أنفسهم في نهاية مسارهم أمام خيار غير متوقع؛ إما أن يصيروا بدورهم أساتذة للأدب، أو يسجلوا أنفسهم في لائحة العاطلين.[11]
3-3- نشوء علم الجمال الحديث:
ليست أطروحة “الأدب ليس مرتبطًا بعلاقة ذات دلالة مع العالم”، حسب تودروف، من ابتكار أساتذة الأدب اليوم، ولا إسهامًا أصيلاً للبنيويين، لذلك يلجأ تودروف إلى البحث في مراحل تشكل هذه الأطروحة. وينطلق بداية من أن علاقة الأدب بالعالم الخارجي مؤكدة بقوة فيما يسمى بالنظرية الكلاسيكية للشعر، ويستدل تودروف بأرسطو حول محاكاة الأدب للطبيعة. ووظيفة الأدب، حسب هوراتيوس، هي المتعة والفائدة، وكان الشعر، في أوروبا المسيحية للقرون الأولى، يستخدم لتبليغ وتمجيد مذهب، وتم خلال عصر النهضة ربط الشعر بالجمال، هذا الجمال الذي يتحدد بحقيقته وإسهامه في الخير.[12] لكن هذا التصور للأدب تزعزع خلال العصور الحديثة، حسب تودروف، وذلك عبر طريقتين ترتبطان معًا بالنظرة الجديدة إلى العلمنة المتزايدة للتجربة الدينية، مما أدى إلى تقديس الفن.
ترتبط الطريقة الأولى باستعادة صورة قديمة ترتبط بالفنان المبدع الشبيه بالإله المبدع الذي ينتج مجموعات متناسقة ومنغلقة على ذاتها. لقد تم الاحتفاظ بفعل المحاكاة، لكن تم الانتقال به من محاكاة الأدب للعالم إلى محاكاة ترتبط بفعل الإنتاج ذاته، محاكاة الفنان المبدع للإله المبدع في القدرة على الإبداع، وليس فقط في نوع وطبيعة الإبداع.[13]
ترتبط الطريقة الثانية بقطع الصلة بالرؤية الكلاسيكية، وذلك عبر القول إن هدف الشعر ليس محاكاة الطبيعة، بل إبداع الجمال باعتباره تجسيدًا للكمال، وهكذا لم يعد المبدع في حديثه هو الذي تتم مقارنته بالإله بل العمل الأدبي في كماله.[14]
3-4- جماليات عصر الأنوار:
ينطلق تودروف من ربط روح عصر الأنوار، القائمة على استقلال الفرد، بالمنظور الجديد للفن الذي دخل ضمن هذه السيرورة الفكرية الجديدة، إذ أصبح ينظر للفن في استقلاله، وكذلك ينظر لقيمة الفنان في تحرره وتحرر عمله الفني.[15] من هذا المنظور يعتبر تودروف أن مفكري القرن الثامن عشر كانوا يسعون إلى التمييز بين طريقتين؛ طريقة الشعراء، وطريقة العلماء والفلاسفة، وقد ميز، في هذا السياق، الفيلسوف والبلاغي “جامبتستا فيكو” بين اللغة العقلية واللغة الشعرية، وهما لغتان تتعارضان مثلما يتعارض العام مع الخاص. وحضر هذا التصور نفسه مع “باومكارتن” الذي تصور الشعر إبداعًا لعالم ممكن بين عوالم أخرى. وقد اهتم “ليسينغ” بهذا المنظور حينما اعتبر أن العمل الفني يطمح إلى إنتاج الجمال الذي لا يخضع لغرض خارجي. ويصل تودروف إلى “كانط” من خلال كتابه “نقد ملكة الحكم” الصادر عام 1790 الذي أثر على مجموع التفكير المعاصر حول الفن، حينما أكد على أن الجمال منزه عن الغرض.
3-5- من الرومانسية حتى الحركات الطليعية:
يعتبر تودروف أن علم الجمال الرومانسي، الذي فرض نفسه خلال مرحلة القرن التاسع عشر، لم يأتِ بقطيعة، فقد حول مركز ثقل المحاكاة إلى الجمال وأكد استقلالية العمل الفني، هذا من جهة، ولم يكن، من جهة أخرى، يجهل العلاقة التي تربط الأعمال الأدبية بالواقع. لكن الأمر الجديد لدى الرومانسيين هو حكم القيمة الذي يصدرونه على مختلف صيغ المعرفة، والتي يمكن بلوغها عن طريق الفن، حيث تبدو لهم متفوقة على صيغة المعرفة العلمية، باعتبارها تخلق واقعًا جديدًا محظورًا على الحواس وعلى العقل.[16]
وينتقل تودروف إلى مرحلة القرن العشرين في علاقة بالحركات الطليعية التي تمثل ما يعرف بـ “الفن الحديث”. وقد كانت البدايات الأولى لهذه الحركات في روسيا حوالي 1910 في ارتباط بالتجريد في الرسم والابتكارات المستقبلية في الشعر، وصار مطلوبًا من الرسم تناسي العالم المادي، وألا يرضخ لقوانين الرسم الخاصة به. ويطمح المستقبليون في الشعر إلى تخليص اللغة من صلتها بالواقع عبر خلق لغة ما وراء ذهنية، وسيتم تجسيد هذا التصور الجديد القديم من طرف الشكلانيين الروس، الذين اعتبروا أن الفن والأدب لا يقيمان أية علاقة ذات معنى مع العالم، وكذلك سيحضر مع المتخصصين في الدراسات الأسلوبية المورفلوجية في ألمانيا وعند أتباع ملارمي في فرنسا وأنصار النقد الجديد في الولايات المتحدة. ويخلص تودروف إلى أن هذه الشكلانية تقترن سلفًا بعدمية تغذيها معاينة الكوارث التي ميزت التاريخ الأوربي في القرن الماضي.[17]
3-6- ماذا يستطيع الأدب؟
ينطلق تودروف من واقعتين مشحونتين بالدلالة، فيما يخص قيمة الأدب في حياة الإنسان، ترتبط الأولى بـ”جون ستيوارت مل” الذي أصيب بانهيار عصبي خطير في العشرين من عمره، إذ أصبح فاقد الحس بكل لذة وبكل إحساس ممتع، جرب كل أنواع العلاج بلا جدوى ليستقر اكتئابه على الدوام. امتدت هذه الحال لعامين، ثم انفرجت شيئًا فشيئًا، إذ لعب كتاب قرأه “ستيوارت مل” دورًا فريدًا في شفائه، وهو ديوان شعر لـ “ورد مورث” وجد فيه التعبير عن إحساساته الخاصة، وقد تسامى بها جمال الأبيات. وترتبط الواقعة الثانية بامرأة شابة وجدت نفسها حبيسة السجن في باريس، حيث تآمرت ضد المحتل الألماني وقبض عليها، ظلت حبيسة في زنزانتها لا حق لها في الكتب، لكن رفيقتها في الطابق الأسفل تستطيع استعارة المؤلفات من المكتبة، وكانت تصلها خفية، ومنذ ذلك الحين سكن “فابريس دل دونكو” بطل رواية “شارتريه بارما- ل ستا ندال” أيضًا زنزانتها وأصبح رفيقًا لها يخفف عنها ألم السجن والوحدة.[18]
يعتمد تودروف الحادثتين، ليؤكد أن الأدب يستطيع فعل الكثير، يستطيع أن يمد إلينا اليد حين نكون في أعماق الاكتئاب، ويقودنا نحو الكائنات البشرية من حولنا، ويجعلنا أكثر فهمًا للعالم من حولنا، ويعيننا على أن نحيا. لكن لكي يقوم الأدب بهذه الوظيفة الإنسانية، يجب أخذه بالمعنى الواسع والقوي الذي هيمن في أوروبا حتى نهاية القرن التاسع عشر، وصار مهمشًا اليوم، بينما ينتصر تصور مختزل على نحو غير معقول. ويضيف تودروف موضحًا: الأدب، مثل الفلسفة والعلوم الإنسانية، فكر ومعرفة للعالم النفسي والاجتماعي الذي نسكنه، والواقع الذي يطمح الأدب إلى فهمه هو بكل بساطة التجربة الإنسانية.[19]
3-7- تواصل لا ينفد:
ينطلق تودروف من أطروحة “أن الأفق الذي يندرج فيه العمل الأدبي هو العالم الموسع الذي تفضي إليه حين تلتقي بنص سردي أو شعري”، وينطلق تحديدًا من مراسلة شهيرة بين “جورج ساند” و”كوستاف فلوبير” حول الصلة بين الأدب والحقيقة والأخلاق، إذ يستنتج أنه رغم الاختلاف في التأويل بين المتراسلين، فإن تصور الأدب باعتباره فهمًا أفضل للوضع الإنساني يحول من الداخل كينونة كل واحد من قرائه، موجود عند المتراسلين. وهنا يتساءل تودروف: أليس من مصلحتنا نحن تبني وجهة النظر هذه، وتحرير الأدب من المشد الخانق الحبيس فيه، والمصنوع من ألعاب شكلانية وشكاوى عدمية وتمركز أناني على الذات؟ ويعد تودروف، في علاقة بالخطاب النقدي، أن فهمًا للأدب موسعًا يمكنه أن يجذب النقد نحو آفاق أوسع، وذلك بإخراجه من “الغيتو” الشكلاني الذي لا يهم إلا نقادًا آخرين، وفتحه على السجال العريض للأفكار الذي تشترك فيه كل معرفة للإنسان.[20]
وكما بدأ تودروف بالحديث عن علاقة الأدب بالتعليم المدرسي، فإنه أنهى كتابه بالإشكالية نفسها، وهو يوضح بشكل صريح أنه لا ينبغي بعد الآن أن يكون هدف تحليل الأعمال الأدبية في المدرسة هو إيضاح المفاهيم التي استحدثها هذا العالم أو ذاك من علماء اللسانيات، أو هذا المنظر أو ذاك، بل يجب أن يكون الهدف من تحليل النصوص الأدبية، حسب تودروف، هو الوصول بنا إلى معناها، لأن هذا المعنى هو الذي بإمكانه أن يقودنا نحو معرفة الإنساني. ويختم تودروف الفصل الأخير من كتابه بصيحة أكثر تعبيرًا، محذرًا من الخطر المحدق بالأدب في عالمنا المعاصر، نتيجة إفراغه من محتواه الإنساني وربطه بألاعيب شكلانية. إنهم يغتالون الأدب، لا بدراسة نصوص غير أدبية في المدرسة، بل بجعل الأعمال الأدبية مجرد أمثلة إيضاحية لرؤية شكلانية أو عدمية أو أنانية للأدب.[21]
————
[1]- ميلان كونديرا، فن الرواية، تر: أمل منصور، ط 1، 1999، ص 18
[2]- تزفتان تودروف، الأدب في خطر، تر: عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال، ط 1، 2007، ص ص 8- 11
[3]- المرجع نفسه، ص 8
[4]- المرجع نفسه، ص 9
[5]- المرجع نفسه، ص 6
[6]- le monde: 07-12-1984
[7]- تزفتان تودروف، الأدب في خطر، ص ص 11-12
[8]- المرجع نفسه، ص 16
[9]- المرجع نفسه، ص 17
[10]- المرجع نفسه، ص 18
[11]- المرجع نفسه، ص 19
[12]- المرجع نفسه، ص ص 23-24
[13]- المرجع نفسه، ص 24
[14]- المرجع نفسه، ص 25
[15]- المرجع نفسه، ص 29
[16]- المرجع نفسه، ص 35
[17]- المرجع نفسه، ص ص 40-41
[18]- المرجع نفسه، ص 44
[19]- المرجع نفسه، ص 45
[20]- المرجع نفسه، ص 52
[21]- المرجع نفسه، ص 54