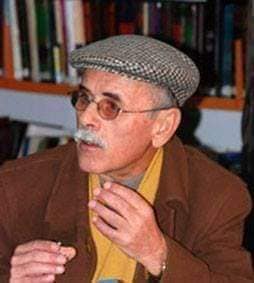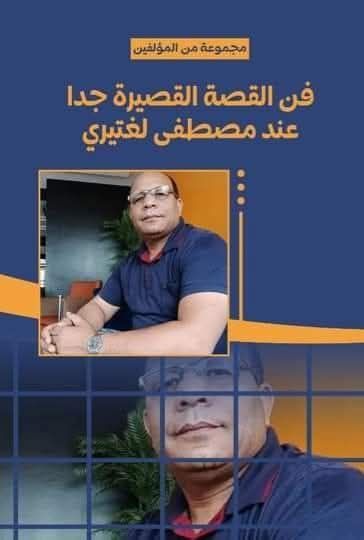حاجة الرواية العربية إلى الحكاية..
■ الكاتب: د. رشيد بنحدو
حين أخبرني مرة أحد الروائيين الأصدقاء، بأنه أرسل روايته الأخيرة إلى لجنة تحكيم عربية تجازي سنويّاً أحسن رواية في العالم العربي، قلت له: إن حظ روايتك بالفوز ضعيف، حتى لا أقول منعدم. وهو ما أجابني عنه معترضاً بكل زهو وخيلاء: بالعكس، لقد خضتُ في الرواية مغامرة في التشكيل والتشخيص والتخييل والأسلبة، وهو ما يؤهلها دون شك للظفر بالجائزة هذا العام. فدعوتُ له بالتوفيق. لكن روايته لم يحالفها الحظ منذ أولى مراحل القراءة والفرز، حيث كانت الجائزة في النهاية من نصيب كاتب هو وصاحبي على طرفي نقيض، تصوراً وتدبيراً لفن الرواية. ترى ما الذي جعلني أخيّب أمله في الجائزة؟
أعترف أولاً بأنني قارئ وناقد معجب بصاحبي، من جهة تميزه بإدمان البحث عن النادر الطريف في طرق السرد الروائي، وهو ما يجعل من رواياته ورشاً نصياً لتجريب تقنيات واختبار أشكال. لكن ما يسترعي انتباهي دائماً، هو أن هذه الروايات تفتقر إلى نواة حكائية صلبة تتناسل منها تدريجيّاً أحداث، حقيقية أو متخيلة، تقع لشخصيات ذات عمق وجودي وكثافة سيكولوجية مثلاً. فما يحدث فيها هو بالأحرى اللا حدث. ولهذا السبب، لا تلقى- لا غرابة في هذا- أي صدى إيجابي واسع لدى النقاد وأعضاء لجان الجوائز، بله عموم القراء. فوحدهم النقاد هم ذوو التوافق الفني والفكري مع صاحبي، أي المنتمين مثله إلى الحساسية الجمالية الحداثية -وهم قليلون جداً- مَنْ يحبّرون على هامش رواياته مقالات كلها مدح وإعجاب، انطلاقاً من واجب التواطؤ والمجاملة أحياناً.
ما يتذرع به كثير من القراء، وحتى بعض النقاد، هو بالبداهة نعتهم لهذه النصوص بالغموض. وإذا جاز لي أن ألتمس لهم العذر، فسأقرر من غير قصد انتقادي- بأن هذه النصوص هي فعلاً عصية على الفهم. والسبب أن السرد فيها إشكالي؛ فهو يوحي منذ البداية بأنه سينطلق بإيقاع خطي يجعل المتخيل الروائي يتشكل تدريجياً، لكنه سرعان ما يتعثر ويتشذر لتنوب عنه متواليات حكائية متنافرة يحار القارئ العادي إلى أي صوت سردي ينسبها، لأنها تعود على أصوات متعددة لكل واحد منها بؤرة سردية وكذا ضمير نحوي خاصان به.
ولعل ما يترتب عن هذه الفوضى المتعمدة هو افتقار النص، كما قلت سابقاً، إلى نواة حكائية صلبة، أعني إلى بؤرة محورية تتلاقى أو تتفرق عندها الأحداث المحكية. فلا شيء فيه ينم مثلاً عن وجود قصة أو مغامرة تطرأ فيها مفاجآت وتوترات وانقلابات هي بالضبط ما يبحث عنه القارئ. فكل ما فيه هو تدفق هادر لصور استحواذية واستيهامات هوجاء بواسطة لغة هذيانية، تكثر فيها الثقوب والبياضات التي تتطلب، حسب أمبرتو إيكو، (قارئاً متعاوناً) يتدخل ليملأها، فيتحول من مجرد قارئ سلبي مستهلك إلى قارئ إيجابي يعيد كتابة النص. وهي الكفاية الإنتاجية والتأويلية التي يفتقدها القارئ العادي.
ولا شك في أن ما يفاقم هذه الفوضى، هو استبهام البنية الفضائية للنص على القارئ العادي، بسبب غلوّها في التجريد والمفارقة: فهي إجمالاً لا تصور أفضية الحدث -أو بالأحرى اللاحدث- كما هي جلية في الواقع، بل تعمد إلى تضبيبها وتعتيمها لتكون صورة أمينة لانبهام الشخصيات وهيوليتها: فلا هي موسومة بصفات تجعلها مقابلاً موضوعياً لأشخاص من لحم ودم، ولا هي ملقبة بأسماء تحدد هويتها الذاتية، كما يقضي الحس السليم بهذا، إذ هي مسماة بمجرد حروف صماء بكماء.
المتخيل الحكائي وتحديات العالم الرقمي وبالتلازم مع هذا التدبير النوعي الغريب للفضاء، فإن البنية الزمنية نفسها تتسم بنوع من اللا تحديد الذهني، الذي يجعلها مباينة للزمن الفيزيائي: فلا وجود لقرائن مادية تفرق بين الحاضر والماضي والمستقبل. وحده الزمن النفسي ما تلوذ به شخصيات إشكالية مستغرقة في مونولوج داخلي عميق، ومجترة لهلسنات عُصابية سوداوية تنم عن اضطرابات نفسية وعقلية.
ولا يسع القارئ العادي سوى أن يستغرب اندساس خطاب غير حكائي في النسيج النصي، يزاوله المؤلف بغرض التأمل في الرواية وهي تنكتب وتتشكل، الأمر الذي يؤدي إلى ازدواج الخطاب السردي الشامل بآخر نقدي وتنظيري مقحم لم يألفه القارئ، وهو ما يفضي عادة إلى ارتباكه وانصرافه عن متابعة القراءة.
ينضاف إلى كل هذا أن الرواية تتسم بنزوع استكفائي إلى الاستقالة من الواقع الموضوعي، وإلى الدوران العبثي المدوخ في حلقة مفرغة من الهواجس والأخيلة المَرضية، التي تستبد بالذات الفردية للمؤلف.
إن أهم ما يبرز من هذا التوصيف الموجز للروايات ذات المنحى الحداثي أمران أساسيان اثنان: الأول هو تبئيرها بسبق تصميم على الذوات الفردية للمؤلف -السارد وللشخصيات الروائية ومفارقتها لواقع الحال المرتبط بالسياق المرجعي العام، الذي يُفترض تكييفه لفعل الكتابة، إنتاجاً وتلقياً. فهي تمعن في التحلل من أية وظيفة إحالية تجعل منها وثيقة تؤرخ لمرحلة ما من مراحل تطور المجتمع. والثاني هو أنها تتطلب قارئاً متمرساً يحتاز قدرات ذهنية وتأويلية استثنائية، تخوله أن يتفاعل إيجابياً مع النص، فيقوم بتحييد خاصية اللا تحديد والغموض فيه. وهو ما يتعذر تكوينياً على القارئ العادي، الذي اعتاد قراءة روايات واقعية، سهلة ومريحة، تضمن له سلاسة الفهم والاستمتاع.
لعل الحصيلة التي يتعين استخلاصها الآن هي ما يمكن إيجازه في هذا السؤال: أية رواية لأي قارئ؟ لأن قارئ اليوم هو غير قارئ الأمس، فإن أسئلته وانتظاراته تتطلب أن تستجيب لها الرواية بطريقة مختلفة. ولعل ما يؤكد هذه الحقيقة البدهية هو عزوف شريحة عريضة من القراء، وحتى النقاد، عن قراءة الروايات المولعة، دونما اعتدال، بالتخييل واللعب والتجريد والتجريب، وذلك على حساب حكاية هي أساساً ما يبحثون عنه. الحكاية: هو ذا أفق التوقع لدى القارئ العربي المعاصر، إنه ينتظر من الرواية أن تمنحه إحساساً بالحرارة والارتجاج، يجعله يقلّب الصفحات بسرعة ترقباً لانفكاك حبكة مشوقة متقنة، وهو ما لا يتأتى لها إلا بسرد حكاية، في هيئة مغامرة أو تجربة معيشة، تنبض بالحياة والتوتر، حكاية في كامل كثافتها وعنفها ونبوءتها الأكثر واقعية.
إن الرواية الجيدة هي تلك التي توازن بين اشتراطات الوفاء بالواقع، والوفاء بمتطلبات الإبداع الفني، باعتبار أن الرهان ليس هو فقط الكتابة عن الواقع، بل أيضاً كتابته بالتسامي عليه وتخييله وأسلبته، وهو ما يعني تأرجحاً مستمراً بين الواقعي والمتخيل. فليس التنابذ، وإنما التنافذ ما يميز العلاقة بينهما. إن مطلب الواقعية الصارمة، سيظل قاصراً ما لم يتم ابتكار واقع آخر، يجعل القارئ يعاين ما يمور تحت سطح الواقع المرجعي الملموس من حقائق وتحديات.
لذلك، فالرهان الوحيد الذي يواجهه الكاتب هو ذو طبيعة جمالية، وهو أن يتصور متخيلاً حكائياً انطلاقاً من الواقع المعيش، متخيلاً يجعل هذا الواقع أكثر واقعية، ومن ثم يخلق مع القارئ علاقة وجدانية، ويحرك فيه أسباب الاعتقاد بصدقية عالم الرواية.
فما أحوج الرواية العربية اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى عودة (الحكاية) إليها باعتبارها منهجاً تجريبياً لرصد الواقع العربي وآلية للتأمل فيه، وهو ما لا يتم إلا باستنفار الكاتب لإمكانيات اللعب والحلم والسخرية، والكفيلة وحدها فنياً واستعارياً بتشكيل واقع آخر مختلف. فما يهم جمهور القراء العريض هو توفيق النص بين هذه الإمكانيات من جانب، ومطلب استيحاء الواقع من جانب آخر. فبواسطة هذا الإجراء، يتم دفع الواقع الملموس إلى أقصى حدوده من أجل بلورة أوجهه الأكثر مأساوية، ومن جهة أخرى يجعل القارئ، يشعر بأن المتخيل الحكائي الذي سيُقبل عليه ليس غريباً عنه بقدر ما سيطمئنه، ومن ثم يغريه بعدم التطويح بالرواية ورميها بعيداً عنه.
لاغرو من أن هذه الضرورة، تزداد استعجاليتها وحدّتها اليوم أمام التحدي الشرس للطاقات الرقمية، التي أصبحت تنافس الرواية في صميم اختصاصها، ألا وهو خلق عوالم ممكنة. ذلك أن على الرواية، هنا والآن، إن هي أرادت أن يكون لها، بل أن يبقى لها أثر ما، أن تتصدى لهذا التحدي بإمعانها في تخييل الواقع وأسلبته ليتسامى على واقعيته ويرتاد أفضية التوقع، أي أفضية الافتراض السحري. على هذا النحو، تكف الرواية عن كونها كتابة عن واقع جاهز لتكون كتابة له، أعني خلقاً تدريجياً له في أثناء سيرورة الكتابة. ففي تصور القارئ أنه لا وجود للواقع بذاته قبل شروع الكاتب في كتابة روايته. فالروائي، حين يفكر في كتابة رواية، لا يشغل ذهنه أي شيء آخر عدا الكتابة، التي تستحثه على التعجيل بأخذ القلم والورق. وحدها حركات الكلمات ومشاريع الأشكال، وتقنيات التخييل وأساليب التفضية وطرائق التشخيص ما يستحوذ على فكره، تماماً مثلما لا تحتل رأس الرسام سوى الخطوط والألوان. أما الباقي، أي ما يقع في الرواية، فسيأتي لاحقا من تلقاء نفسه.
لقد قال لوي أراغون مرة إن مهمة الرواية هي أن (تكذب بصدق). وهو ما يحلو لي أن أحوّره ليصبح (أن تَصْدُقَ بكذب)، أعني أن تقول الواقع كما تفتقت عنه مخيلة الكاتب وهواجسه واستيهاماته. وهذه حاجة يبدو أن القارئ العربي أصبح اليوم، وأكثر من الماضي، ينتظر من الرواية تلبيتها وإشباعها. دليلي على هذا أن بعض الباحثين الأمريكيين أصبحوا مقتنعين بأن بإمكان الأفراد تنمية هويات افتراضية، تكون بمثابة عوامل تنفيسية تخفف عنهم وطأة الأرقام والشاشات في الحياة المعاصرة، وما يترتب عنها من استلاب قاهر. وتبتدئ هذه العوامل بأحلام اليقظة لتنتهي بمواجهة الواقع، مروراً بإسقاطات الذات ومشاريع الحياة، حيث يسعى كل واحد إلى تجريب نُتَفِ سيناريوهات لأجل بناء هويات جديدة تُنسيهم عنف الواقع.
هذا فيما يبدو هو الهم الجديد للإنسان المعاصر الذي يتطلب وقوداً. ولا شيء سوى المتخيلات يستطيع توفير هذا الوقود، لاسيما المتخيل الروائي، لأن متخيلات الشاشة السينمائية والتلفزية تعفي المُشاهدَ من بذل مجهود التماهي ومن متعته بسبب ضياعه في الصورة والصوت، أما متخيل الرواية، فيسمح للقارئ بإعادة بناء العالم استعارياً، من خلال حكاية مغامرة أو تجربة تعويضية، باعتبار هذه الحكاية فضاء، تُرَاعَى فيه الحدود بين الانغمار في عالم مستَوْهم ونسيان الذات بما هي شخص عينيّ.
فيا صاحبي، ويا أيها الروائيون الحداثيون، اتركوا نصوصكم تستعيد ألق (الحكاية) وفتنتها، من غير تضحية بلوازم الإبداع الفني. فلا تعتقدوا بأن في هذه الاستعادة استقالة ما من الواقع الذي تعيشون فيه، أو أنها تحرم نصوصكم من كل بعد اجتماعي. ذلك (أن حاجة المجتمع اليوم إلى (الحكاية)، من حيث هي السناد لمتخيلاتكم الروائية، هي أكثر من حاجته إلى الحديد والإسمنت)، كما يقول عالم الاجتماع الفرنسي جان-كلود كوفمان، وذلك على رغم أن هذا الظمأ إلى (الحكاية) قد لا يخلو من تناقض بسبب كونه مواساة وإعادة تبئير على الذات في آن. فإذا أراد المرء أن يبتكر نفسه ذاتاً، فإن عليه أن يبتكرها مختلفة بتشغيله لمتخيل شخصي ولأحلام يقظة، تتيح تنميات ممكنة لشخصيته. هنا تبرز أهمية متخيلاتكم التي تستطيع أن تكون أداة للاشتغال على الذات، وكذا آلية لإحداث القطيعة من أجل ابتداع واقع جديد. ومن ثم، فإن قراءة نصوصكم يمكن لها، في المدى الأمثل، أن تغير القارئ عبر تماهيه مع ذات البطل الروائي، واكتشاف ذوات أخرى ممكنة، قبل أن تستعيده الرتابة الأصلية لحياته اليومية. بهذا المعنى، وليس بسواه، تكون عودة (الحكاية) بامتياز لحظة لا تركيزٍ أساسية تنسيه مآسي الواقع المعاصر.