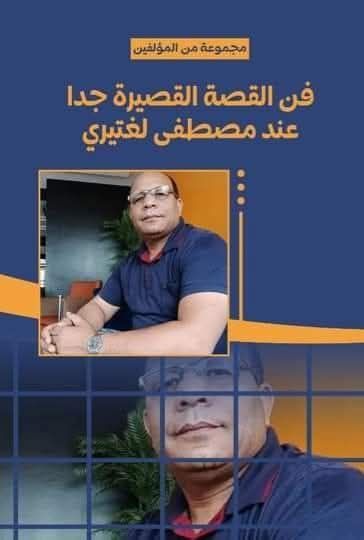حوار مع أديب البحر
الشراع والعاصفة ” فازت بجائزة أفضل رواية ترجمت إلى الإيطالية
حاوره ماجد رشيد العويد
في الرواية العربية، لا يذكر البحر إلا ويذكر حنا مينه،
تعليقات 1تعليق واحد بانتظار الموافقة
وكأنهما توأمان بل هما كذلك، انبثقا من رحم الساحل السوري، ليبلورا معاً أدباً خالداً في الزمان. ومن ” المصابيح الزرق ” إلى ” حارة الشحادين ” مروراً بثلاثيتين .. والثلج يأتي من النافذة والشمس في يوم غائم، رحلة ملأى بالصعاب،
فالصبي يكاد يهلك بحثاً عن لقمة العيش وكذلك يفعل الفتى لإعالة عائلته،
ثم الشاب الذي انطلق مع قصصه القصيرة، وصولاً إلى بزوغ نجمه مع روايته ” الشراع والعاصفة ” وليس انتهاء بتكريمه مرات على امتداد العالم، لإثمار جهوده في حقل الرواية، وتكريماً لعمر مضى شاقاً وعسيراً نصفه الأول.
تقرأ حنا مينه، فتظن أنك تقرأ ملاحم في الشعر.. هكذا تترك فيك “الياطر” من انطباع وتقرأ ” الشمس في يوم غائم ” فتبصر نفسك في قلب الأسطورة تعانق تلك التفاصيل المغرقة في القدم،
ويحيلك الشعور الداهم بالرمز من حيث تدري ولا تدري إلى تلك الأيام الخوالي من رحلة الإنسان في بحثه عن المعرفة. ولأجل هذا كله، ولانتهاء هذا الأديب إلى سدة العالمية بترجمة كتبه إلى العديد من اللغات الأجنبية. كان لمجلة ” الكويت ” هذا الحوار:
س1 ـ أريد أن أبدأ من انسحابكم أنتم والمرحوم سعد الله ونوس من اتحاد الكتاب العرب ما هي مبرراته، وتبعاته؟
ج1 ـ ليس في الموضوع تبعات، وإن كانت له مبررات، وبدءاً أقول: من يخدم المذبح، من المذبح يأكل، وقد خدمت هذا المذبح، وصعب علي أن آكل منه، لسبب بسيط هو أنني لا أستسيغ أن أخدم بأجر، فيما يتعلق بالخدمة المجانية التي أعتبرها واجباً، لرفعة الأدب والأدباء، كي تتواصل أجيال المبدعين، فلا يكون هناك انقطاع بين جيل وجيل.
لقد كنت من مؤسسي رابطة الكتاب السوريين عام 1951 ، وكنت من الذين شاركوا في المؤتمر الأول للأدباء العرب عام 1954 ، الذي شاركت فيه الصفوة من هؤلاء الأدباء، ومن جميع البلدان العربية، يتقدمهم شيخ الأدب مارون عبود،
بدعوة من الرابطة، وعن هذا المؤتمر انبثقت رابطة الكتاب العرب، فانتسب إليها الكثيرون، من الباحث المرحوم حسين مروة، إلى القاص المرحوم يوسف إدريس، إلى الشاعر المرحوم عبد الوهاب البياتي، إلى أمثالهم من كبار المبدعين العرب.
ثم كنت من مؤسسي اتحاد الكتاب العرب في سوريا عام 1968 ، وقد كان العنوان المقترح لهذا الاتحاد هو التالي: ” اتحاد الكتاب العرب والعاملين في الحقل الثقافي ” وفي الجمعية التأسيسية، برئاسة المرحوم سليمان الخش،
ومع أنني من المكتب التنفيذي الأول لهذا الاتحاد مع الشاعر علي الجندي، والشاعر ممدوح عدوان، والروائي حيدر حيدر وغيرهم، فإن ميلي ظل إلى جانب الاتحادات غير الرسمية للكتاب، وتتابعت المكاتب التنفيذية للاتحاد، انتخاباً وتعييناً، وكنت، لعدة دورات، من أعضائها، وسررت لأن المسرحي العربي الكبير سعد الله ونوس، أصبح من أعضاء المكتب التنفيذي، في دورتيه الأخيرتين، اللتين كنت فيهما، وبعد ذلك خرجنا معاً.
وعندما فصل الاتحاد الشاعر الكبير أدونيس من عضويته، دون مناقشة أو محاكمة، بسبب تهمة التطبيع مع العدو الإسرائيلي التي نسبت إليه، قررنا، سعد الله ونوس وأنا، الاستقالة من عضوية الاتحاد، انتصاراً للحق، ودفعاً للغبن اللاحق بأدونيس، المفصول دون تحقيق من الاتحاد معه، حتى لا يصبح ذلك إجراء له سابقة، مع أنني،
وأقول هذا بالنسبة إلي، أختلف مع أدونيس في كثير من أفكاره ومواقفه، ومنها الموقف الذي فصل لأجله دون مساءلته على النحو الذي تفرضه الأصول، ونشرت الاستقالتان في الصحف وهما معروفتان من الجميع، ومعللتان تعليلاً لا لبس فيه، وكان المرحوم سعد الله مريضاً آنذاك، وأحسب أن موقفه من واقعة فصل أدونيس مثل موقفي، وقد استغربنا، حين قرأنا، بعد أيام خبراً في إحدى صحف الاتحاد، مفاده أننا فصلنا من عضويته لأننا مع التطبيع!!!
هذه هي قصة استقالتينا، سعد الله وأنا من عضوية اتحاد الكتاب العرب، وبكل دقة ممكنة، وموقفنا ضد التطبيع معروف، وأنا لست ضد اتحاد الكتاب العرب، لكنني أفضل أن أبقى مستقلاً عن كل اتحادات الكتاب العرب المماثلة، مع الاعتراف أن اتحادنا في سورية قدم، ويقدم، لأعضائه خدمات وفوائد هم بحاجة إليها، ولولاه ما توفرت لهم.
س2 ـ هل الرواية العربية وبحسب تعبير الدكتورة نجاح العطار في تقديمها رواية ” الشمس في يوم غائم ” ما تزال ” تعابث صخرة سيزيف، وتراوح بين السقف والقمة ” أم أن لها اليوم شأواً آخر خاصة ونحن نشهد جيلاً من الروائيين هاماً، ولعل أسماء من مثل إبراهيم الكوني من الأسماء الدالة على نضج هذا الفن؟
ج2ـ الرواية العربية نهضت بصخرة سيزيف إلى مكانها في الأعلى، حيث استقرت في محليتها والعالمية، وهذه الرواية، التي قلت عنها في عام 1982، بشهادة الناقد محمد دكروب في كتابه ” حوارات
وأحاديث ” مع حنا مينه، إنها ستكون ديوان العرب في القرن الواحد والعشرين، قد كانت ديوان العرب في القرن العشرين نفسه، وتحول الجميع إلى كتابة الرواية، هذا الفن الصعب، حتى أن أدونيس وسعدي يوسف وغيرهما، من الشعراء الكبار، أعلنوا أنهم سيكتبون الرواية، لذلك بت أشعر بالذنب لأنني قلت ما قلته حول الرواية وصيرورتها ديوان العرب.
لقد ترجمت روايات نجيب محفوظ، أحد مؤسسي الرواية العربية، إلى لغات كثيرة، بعد نيله جائزة نوبل بجدارة، وقد رشحني، مشكوراً، إلى هذه الجائزة فور تلقيها، لكنني ما باليت، ولن أبالي، بالجوائز، إنما علي أن ألاحظ، هنا،
أن رواية، أو روايتين، أو ثلاث، لا تصنع عالماً روائياً، وأزعم، وقد أكون على خطأ، أن هناك اثنين صنعا هذا العالم الروائي، هما نجيب محفوظ وحنا مينه، بصرف النظر عن المحتوى والسوية الفنية، اللذين من حق النقاد أن يعطوا رأياً فيهما،
فقد أعطى نجيب محفوظ للرواية العربية الكثير، وأعطيت أنا للرواية العربية ثلاثين رواية، وهناك روايات جاهزة، وروايات تحت الطبع، وروايات لم ير أبطالها النور بعد،
وقد ترجمت رواياتي إلى ما يزيد عن سبع عشرة لغة، منها الفرنسية والإيطالية والإسبانية، والإنكليزية والروسية والفارسية وغيرها، مثل الألمانية والتشيكية والأوزبكية، ولغات بعض الجمهوريات السوفيتية سابقاً،
وفازت روايتي ” الشراع والعاصفة ” عام 1993 بجائزة أفضل رواية ترجمت إلى الإيطالية، ودعيت لتسلم الجائزة لكنني اعتذرت بسبب المشاغل.
هل هذا للمباهاة؟ لا! بل هو للتأكيد، أن الرواية العربية تخطت محليتها إلى العالمية، لكنها لم تبلغ ما بلغته رواية أمريكا اللاتينية من الانتشار الواسع بعد، والسبب أن رواية أمريكا اللاتينية لا تضار منها الصهيونية في شيء، بينما الرواية العربية تؤذي الصهيونية، وتفضحها كحركة عنصرية نازية،
لذلك تتربص بها، وتحول دون ترجمتها وانتشارها، بما تملك، الصهيونية، من قوة في الإعلام، وسيطرة على الأجهزة الثقافية في أوربا وأمريكا والعدد الكبير من بلدان الغرب
ورغم هذا فإن الرواية العربية، لروائيين عرب كثيرين، قد اخترقت الحصار الصهيوني، وهي تترجم إلى اللغات الحية في خط بياني متصاعد، عاماً بعد عام.
ولقد قلت وأكرر، أن أدب الرواية رحب، وهو يتسع للجميع، ولكل من يكتب رواية، وهم كثر، ولكل من تحول إليها مجرباً، أو تجاوز التجريب، فمن هذا الكم سيكون النوع،
ولعله أن يكون، مستقبلاً، النوع الأرقى، الذي يخترق جدار الصوت، ولعل غزارة الإنتاج، بالنسبة لكل روائي عربي، تؤدي إلى ما أرغب، وهو أن يكون له عالم روائي متكامل في المقبل من الأعوام،
سواء كان إبراهيم الكوني أو غيره، شريطة المثابرة، وعدم تقطع النَفَس، والخروج من الموضوعات البائخة التي لاكتها السينما العربية، والمسلسلات العربية المنهمرة علينا كالحجارة من كل صوب.
قال ميخائيل شولوخوف، صاحب ” الدون الهادئ ” وجائزة نوبل، في وقت متأخر من عمره ” ليس بوسع الفنان أن يكون بارداً حينما يبدع! ولن يكتب عملاً حقيقياً، ولن يجد أبداً السبيل إلى قلب القارئ بدم سمكة، وبقلب خامل مترهل.. إنني إلى جانب أن يغلي الدم الساخن لدى الكاتب عندما يكتب، وأنا إلى جانب أن يشحب وجهه بالحقد الدفين على العدو حينما يكتب عنه، وأن يضحك الكاتب ويبكي سوية مع البطل الذي يحبه، والعزيز على نفسه “
وقال بيلينسكي، الناقد الروسي الشهير: ” إن الحدث يأتي من الفكرة كما النبتة من البذرة، والبذرة من التجربة، والتجربة من المعاناة ” هذا يعني أن يتخلى من يريدون كتابة الرواية عن سريرهم الوثير، ومقعدهم المريح،
أن ينزلوا إلى دنيا الناس، إلى السوق كما قال عمر فاخوري، أن يتخلوا عن أبراجهم العاجية، أن يغامروا في البحر والبر، أن يكافحوا لأن الحياة كفاح، بداية ونهاية، أن يعرفوا جيداً البيئات التي يلتقطون منها أحداث رواياتهم، أن يكونوا جريئين في تمزيق ما كتبوه ليلاً،
إذا لم يرضهم عندما يتفحصونه نهاراً، أن يتركوا التجريد الفكري البحت، اقصد التجريد الذهني، الذي يؤدي بهم إلى تناول فكرة مجردة، من صنع خيالهم ولا أساس لها في الواقع المعيش، ويعمدوا بعد ذلك، إلى إلباسها ثوب الحدث، وإكساء شخصياتها الخرق البالية، فالقارئ ذكي، ويكتشف اللعبة الذهنية البحتة، بأسرع مما يتصورون.
إنني لست ضد التجريد، على ألا يكون وحده المعوّل عليه، في كتابة الرواية، التي هي حكاية حياة، ومعمار فني أصيل.
س3ـ قلت إنك من جيل ” التجريب” لم تحاول ” الإفادة من التجريب الفني للأساليب الروائية العالمية ” ومع ذلك أسست مع أبناء جيلك من الروائيين لما سميته أنت بالرواية ” ديوان العرب في القرن الحادي والعشرين “. السؤال: الرواية العربية اليوم، وبرغم إفادتها من منجز الغرب، ومن منجز أمريكا اللاتينية، في حقل التنوع والثراء في الأساليب الفنية ما تزل في حيز ” التأسيس ” خلا بعض الأعمال، أم أن لكم رأياً آخر؟
ج3ـ نعم! أنا من جيل التجريب، إلا أنني كافحت طويلاً لامتلاك معلمية كتابة الرواية، وقد امتلكتها وانتصرت، وأفدت من منجز الغرب، غير أنني نأيت بنفسي عن تقليد الصرعات الأدبية المتناثرة كقشور الشعير عند التذرية، في هذا الغرب، وأفهم، وحتى أحسن، الغرائبية في هذه الصرعات، وقد أستخدمها في المكان المناسب، والزمن المناسب، دون أن ألجأ إليها لإدهاش القارئ، كما يفعل هذا أو ذاك، وبقسر غير مبرر.
من قال إن الرواية العربية في ” حيز التأسيس ” بعد؟ الآخر؟ اسمح لي أن أصارحه بأنه غير متابع للرواية العربية بالشكل المطلوب.
س4: إلى أي حد يمكننا اعتبار ” رقصة الخنجر ” نوعاً من أنواع إثبات الوجود؟ وإلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الرقصة امتحاناً لعلاقة الولد بأبيه؟ وهل يمكننا إيجاد رابط ما بين هذه الرقصة الشعبية، وبين الثورة على الظلم والفساد؟
ج4 ـ رقصة الخنجر في روايتي ” الشمس في يوم غائم ” هي ضد الظلم والفساد تماماً، وقد دق الراقص بقدميه الأرض ” ابنة الكلب النائمة ” كي تستيقظ، على نحو ما علمه المحرّض الثوري عازف العود،
ولا علاقة لها بإثبات الوجود، أو امتحان للعلاقة بين الفتى الراقص وأبيه، إلا من حيث أن هذا الأب يسكن القصور،
وأن ابنه الذي علمه الخياط أن ينحاز إلى ساكني الأكواخ، وأن يعبر عن ذلك بدق الأرض النائمة وقد فعل، وفي ختام الرواية يتضح أن الابن، التنين الصغير، لم يستطع مقاومة والده، التنين الكبير، وانهزم أمامه في المواجهة، فسقطت الظلمة بينهما.
إن هذه الرواية، التي تلعب فيها الأسطورة دوراً أساسياً، أكبر من أن تلخص أحداثها، ومدلولاتها، ونتائجها، في مقابلة صحفية، وقد كتبت الرواية وهزيمة حزيران 1967 تمضغها الأفواه،
ومن العنوان الذي هو نبوءة، يتبين أن الشمس، التي هي في يوم غائم، سينقشع عنها الغيم، وتعود إلى السطوع، وهذا ما حدث فعلاً في حرب تشرين 1973 ، الحرب المجيدة التي كان فيها النصر مضموناً للعرب، لولا ثغرة الدفرسوار في الجبهة الجنوبية، وخيانة السادات الذي اعترف أنه أراد من هذه الحرب ” تحريكاً لا تحريراً “،
لذلك أوقف متعمداً القوات المصرية البطلة، التي حطمت خط بارليف الإسرائيلي، عن الزحف لتحرير سيناء كلها، وقد أفادت إسرائيل من هذا التوقف، فسحبت دباباتها ومدرعاتها من الجبهة الجنوبية، وزجت بها في الجبهة الشمالية ضد سوريا، التي اجتازت قواتها، ببطولة نادرة، الخندق الإسرائيلي وحررت، بما يشبه المعجزة، مرصد جبل الشيخ، ووصلت إلى بحيرة طبريا، وهذا كله مفصل، وبتوثيق، في روايتي المرصد.
نعود إلى رقصة الخنجر، ودق الأرض النائمة لتستيقظ، وإلى شاعرية رواية ” الشمس في يوم غائم ” التي بهرت النقاد، لنخلص إلى توفر مقوماتها الناجحة، التي لخصها إيليا اهرنبورغ بالخصائص الأربع التالية:
1 ـ أن يكتب العمل الأدبي بطريقة يتضح فيها الاندماج العاطفي الحار،
2 ـ أن يكون موضوع العمل غير ماثل في وعي الناس،
3 ـ أن يصف الكاتب الإنسان الواقعي الذي يجوز عليه الخطأ والصواب،
4 ـ أن يكتشف الأديب آفاقاً جديدة من ناحية الشكل الفني.
س5 ـ في ” الربيع والخريف ” خروج على المألوف الروائي العربي في النظرة إلى الآخر الأوربي الغربي حيث العلاقة بين شرق وغرب، بينما هنا، في الرواية المشار إليها، فالعلاقة بين شرق عربي وشرق أوربي لم يستعمر بلداً عربياً ولكنه يظل أوربياً. كيف ينظر حنا مينه إلى هذه العلاقة؟
ج5 ـ نظرة طبيعية غير مسبوقة، فمع أن المجر، مسرح رواية ” الربيع والخريف ” بلد أوربي، إلا أنه، كما تقول، غير مستعمر، بل هو، كما البلدان الاشتراكية سابقاً، وقف مع حركة التحرر العربية، وساعدها، مادياً ومعنوياً، للتخلص من الاستعمار.
س6 ـ وهل يمكننا اعتبار ” كرم ” في الرواية نفسها امتداداً لـ ” فياض ” في الثلج يأتي من النافذة ” وهل هما ” ظلا ” حنا مينه؟
ج6 ـ لا! كرم في ” الربيع والخريف ” غير فياض في ” الثلج يأتي من النافذة ” وكلا البطلين غيري.. وقد كتب توماس مان، الأديب الألماني المقاوم للنازية، حول موضوع البطل والمؤلف، والخلط بينهما قائلاً: ” إحذروا هذا التأويل، إحذروا مثل هذه الفضائح، في أسئلتكم: من هو هذا البطل، ومن هي هذه البطلة؟ “
س7 ـ ظل البحر مكاناً مفضلاً لديكم، هل يعود هذا إلى الحميمية بين المؤلف والمكان بفعل النشأة وبالتالي الإخلاص لمفرداته؟
ج7 ـ البحر، دون تشوف، هو أنا في سكينته وفي عصفه، وهو أنا في وداعته وشراسته، وكذلك في كرمه الذي يأبى المقابل، وفي عطائه الذي لا ينتظر الشكر من أحد، فالذي يعطي ويرجو شيئاً مقابل عطائه نذل، والذي من شيمه الكرم، ويتوقع جزاء من وراء هذه الشيمة فاسد، وقد قال شوقي بغدادي في إحدى قصائده: ” وطني أحبك، لا ليرفعني حبي، ولكن تغلب الشيم ” .
وكتب ستاندال، صاحب رواية ” الأسود والأحمر ” الشهيرة في القرن التاسع عشر، في كتابه ” مذكرات سائح ” ما يلي: ” إن الإقامة على شاطئ البحر تقضي على الصغائر، والحديث إلى بحار، عائد من رحلة، أكثر فطنة من الحديث مع كاتب عقود مدينة بورغ! “
ماء البحر المالح، هو العبرات في عيون اليتامى، هذه التي تكون مالحة إلى حد لا يصدق، وهذا الماء المالح، هو دمي الذي يجري في شراييني، وقد أحببت البحر إلى درجة الجنون، وأحبني هو أيضاَ،
وفي لجته تعمّدت لا في نهر الأردن، وأمام مداه اللامتناه، أقف متأملاً خاشعاً، ذاهباً إلى ما وراء الأفق، حيث تشرق الشمس أو تغيب، كل صباح وكل مساء، تداعبني أمنية أن أرحل، على متنه، فوق طوافة من خشب، تأخذني بعيداً، بعيداً، إلى عوالم مجهولة، قد لا أعود منها أبداً.
لقد كان نهر السين، عند موباسان، قطعة من البحر، وكان يقول: ” إني أجذف وأستحم، وأستحم وأجذف في هذا البحر، وإن عروقي يجري فيها دم الجائلين فيه، وأبهج ما يبهجني بقاربي ذات صباح ربيعي إلى موانئ غير معروفة “
تريدون معرفة البحر؟ ابحثوا عنها في رواياتي، لا في الأدب العربي القديم أو في الأدب العربي الحديث، فهما، قديماً وحديثاً، ليس فيهما ما يسمى ” أدب بحر ” . معي وحدي كان البحر بحراً، في ثماني روايات عن هذا الأزرق الواسع، لذلك أسموني ” أديب البحر ” وأنا كذلك، شاء الحساد أو كرهوا!
س8 ـ الماضي عند حنا مينه منهل أساسي، بل إن القارئ لرواياته يجد البحر كما، اليابسة، له ماض وحاضر. مياه جرت على سطحها أحداث تاريخية كثيرة. كل هذا نجده بين سطوره، وفوق مراكبه. والزمن هذا السادر كالبحر لا يأبه بالبشر. كيف تعاملتم مع هذا البعد، الزمن، وأنتم الكاتب الذي يصف نفسه بالواقعي.؟
ج8 ـ تعاملت على النحو الذي ينبغي، فالحاضر يصبح ماضياً في لحظة تماماً، والرواية ليست قصيدة هي بنت انفعالها الآني، وليست قصة تأخذ من اللحظة المأزومة لقطتها المفردة، الرواية نتاج الماضي مهما يكن راهناً، وهي تحتاج إلى التخمر والنضج في الذات الإبداعية، قبل أن تصبح حياة مرسومة بالكلمات.
أما الزمن فإنه محور مركزي في الرواية، بسبب من أن الرواية لا تتشكل في فراغ، وإنما في مكان محدد، له، ومعه، زمن محدد أيضاً،
وهذا كله من البدهيات، ما دامت الأشياء، فلسفياً، ليست متراكمة بل مترابطة، وترابطها له امتداد في المكان والزمان معاً،
وفي رواياتي، وبشكل جلي، يتعانق المكان والزمان عناقاً اتحادياً في نمو السياق والشخصيات، ويصبح الماضي، مع هذا الاتحاد المكاني الزمني، حاضراً بالضرورة، مع نقطة مهمة، معروفة، مفادها أن الماضي في العمل الإبداعي، غير الماضي في التفكير،
وبالنسبة لي فإنني أكتب عن الماضي دون أن أكون ماضوي التفكير، وهنا الفارق المهم، بين كاتب يتناول الحاضر بفكر ماضوي، وكاتب يتناول الماضي بفكر تقدمي، وتقدميتي تتجلى في كل أعمالي بامتياز، وليست بحاجة لشهادة من أحد.
وهذا الزمن الذي تسأل عنه، له وجودات ودلالات متعددة، إنه، مثل المكان، سجن للشخصية الروائية لا انفكاك منه، وهذا ما يراه، ويؤكد عليه هانز ميرهوف، في كتابه ” الزمن في الأدب” ترجمة د. سعد رزوق.
” إن الزمن وسيط الرواية ـ يقول ميرهوف ـ والحياة الإنسانية تعاش في ظل الزمن، على أن الواقع التام يجري تصوره، بثبات، على أنه ما وراء الزمان وخارجه، لذلك لا تتحقق الحياة المثلى إلا في التحرر من عبودية الزمان.
ويبقى السؤال: هل التحرر من عبودية الزمان ممكنة؟ وفي الجواب أقول: كلا، لأن الحياة البشرية تخضع لكتلة الزمن في سيلانها الأزلي الأبدي.
س9 ـ يميز جورج طرابيشي بين نوعين من الرواية عند حنا مينه، إن جغز التعبير ” المصابيح الزرق، الثلج يأتي من النافذة، الشراع والعاصفة، ” و ” حكاية بحار، الشمس في يوم غائم، الياطر ” ويقول ” نسبة الروايات الأولى إلى الروايات الثانية أشبه بنسبة ما قبل التاريخ إلى التاريخ ” ككيف تنظرون إلى هذا الفصل بين جيلين من الرواية عندكم؟
ج9 ـإنني معجب بجورج طرابيشي، ذي الثقافة الموسوعية، تراثاً ومعاصرة، وقد أخضع رواياتي لمنطقه الفرويدي في كتابه ” الرجولة وأيديولوجية الرجولة ” وكلامه على ” عبادة الرجولة ” عندي، لكنني لست مع هذا التقسيم الجائر لرواياتي!
يبدو أنه لم يقرأ ” الفم الكرزي ” و ” حارة الشحادين ” و ” صراع امرأتين ” وهي من رواياتي الأخيرة، لذلك أعذره.
س10ـ تقول في كتابك ” هواجس في التجربة الروائية ” ” ما عدا المصابيح الزرق ليس هناك أية أفكار تثقل أيما رواية .” و مع ذلك فأنت تنطلق من أيديولوجيا معينة، منحت أغلبية أبطالك روحها. كيف تشرح هذا؟
ج10 ـ لا يخلو أيما كتاب من الأيديولوجيا، و هذا مفروغ منه، وما تبقى كيف نتعامل إبداعياً مع هذه الأيديولوجيا؟ نسقطها إسقاطاً؟ نمرغ بها الحدث تمريغا؟ أم تأتي في السياق، كنسيج مستتر فيه؟ هذه هي المسألة، وكل ما عداها هراء.
س11 ـ ثمة بعض التشابه بين شخصيتي ” زكريا المرسنلي” في ” الياطر ” و ” مفيد الوحش ” في ” نهاية رجل شجاع ” . إلى جانب بعض الملامح المشتركة لهما مع شخصيات أخرى مبثوثة في رواياتك. هل مرد هذا التشابه إلى مقولة ” البطل الإيجابي”، وبالتالي فإن أبطالك يحملون نطفة الخير ليزرعوها في تربة البلاد التي هم فيها، أم أن الأمر على نحو آخر؟
ج11 ـ لا تشابه، ولا بطولة، إيجابية، أنا مع البطل الشعبي الواضح في رواياتي، دون أن آبه بكل هذه السفسطة حول مقولة ” البطل الإيجابي ” التي تلفت من كثر ما لاكتها الألسن.
س12 ـ من إهاب ثورة 1917 خرج مفهوم ” الواقعية الاشتراكية ” وتبلور مع مكسيم غوركي. الآن وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، هل يمكن أن نشهد توطيداً لمفاهيم من مثل ” الواقعية السحرية ” وأخرى تنبثق من إهاب ما يطلق عليه اليوم ” صراع الحضارات ” وكيف يمكن للرواية كفن أن تتعامل مع العالم اليوم؟
ج12 ـ لا! هذا خطأ، الواقعية الاشتراكية لم تخرج من إهاب ثورة أكتوبر 1917 .. إنها موجودة قبل هذه الثورة بزمن غير قصير،
وكل ما فعله مكسيم غوركي، يتأطر في تبنيها، كشعار يكتشف البعد الثالث فيه، أي البعد المستقبلي، بعد أن كانت الواقعية، بكل أنواعها، ذات بعدين، هما الماضي والحاضر،
ومن يرغب بالمزيد فليقرأ كتاب ” الواقعية الاشتراكية ” لمؤلفه س . غروموف، ترجمة الأستاذ عدنان مدانات، حيث يؤكد غروموف : ” إن الواقعية الاشتراكية نشأت في الأدب الروسي قبل انتصار ثورة أكتوبر.. وقد برزت الخواص الرئيسية للواقعية الاشتراكية، وفكرتها المجددة، في متحف كامل من نماذج الأبطال الإيجابيين، لذلك أطلق عليها، آنذاك، الواقعية البطولية “
أحسب أننا شبعنا من التسميات واشتقاقاتها، ولا حاجة بي إلى الواقعية السحرية أو ” صراع الحضارات ” كما تقترح.. إن تعامل الرواية مع العالم اليوم سيتم في حينه، ووفق منطق الأشياء المستجدة في هذا العالم، إنما بمنظور تقدمي، فالأدب الإبداعي، الصادق، كان تقدمياً على الدوام.
س13 ـ لا يجد المتابع اليوم أسماء هامة في القصة القصيرة، كتلك التي قرأنا لها من مثل يوسف إدريس وعبد السلام العجيلي، وإسماعيل فهد إسماعيل، على سبيل المثال لا الحصر. هل يعود السبب إلى خيبة هذا الفن المراوغ في الإحاطة بمتطلبات العصر، أم أن العلة في الذين يكتبون القصة؟
ج13 ـ أحيلك إلى كتابي ” القصة القصيرة والدلالة الفكرية ” ففيه تجد الجواب. وهذا الكتاب، على تواضعه، نفد بسرعة غير متوقعة، وليس لدي، أنا مؤلفه، نسخة واحدة منه، وسيعاد طبعه في المستقبل، وفي ” دار الآداب” على الأرجح، لأن الطبعة الأولى كانت في سلسلة كتاب “الرياض” التي نشرت حلقاته على صفحاتها، وكان من حقها أن تنشره أولاً.
وبهذه المناسبة، أجد سعادة في توجيه تحياتي القلبية الحارة، إلى جميع الزملاء من كتاب القصة القصيرة الذين ذكرت أسماءهم، مع إعجابي بإنجازاتهم الإبداعية ذات الشهرة الواسعة، وإذا كان القراء يفتقدون أمثالهم اليوم، فمرد ذلك إلى طغيان الرواية على القصة القصيرة من جهة، وظهور المبدعين ليس دورياً من جهة ثانية.
أجري في دمشق في منزل الأستاذ حنا مينه في الفترة بين 8 و 14 من نيسان 2002
____________________
عن موقع شام أصدقاء اللغة والثقافة
العربية السورية فرنسا